شرح نص معلمة لاجئة 9 اساسي محور المرأة في المجتمعات المعاصرة - قصيدة معلمة لاجئة للشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد
كود:9eme arabe, محور المرأة في المجتمعات المعاصرة, محور المرأة في المجتمعات المعاصرة 9 اساسي, محور المرأة في المجتمعات المعاصرة تاسعة اساسي, آدونات, آدونات كافيه, لغة عربية, لغة عربية 9 اساسي, لغة عربية تاسعة اساسي, الاجابة على اسئلة نص معلمة لاجئة, معلمة لاجئة محور المرأة في المجتمعات المعاصرة, cha7nas 9eme, char7nas 9eme de base, charh nas, chr7 nas 9eme, تاسعة اساسي, edunet.tn, شرح, شرح نص, شرح نص 9 اساسي, شرح نص معلمة لاجئة محور المرأة في المجتمعات المعاصرة, هارون هاشم رشيد, نص معلمة لاجئة محور المرأة في المجتمعات المعاصرة
قصيدة معلمة لاجئة
:القصيدة
مع الفجر، والفجر لا يُشعره
مع الفجر، راقبتها تعبر
على وجنتيها احمرار يذوب
وفي مقلتيها، رؤى تنحر
إلى أين؟ قبل انبلاج الصباح
إلى أين هذا السرى المبكر؟
إلى أين مرت كرجع الصدى
يردده جبل مشجر؟
تخطى الطريق.. ومن لوعة
تكاد، دموع الأسى تَطْفِرُ
فقيل لها في شقوق الخيام
ثلاميذ، من أجلها بكُرُوا
تعَذِّبُ في البرد أجسامهم
وأقدامهم من دم تقطر
تلاميذ كان لهم موطن
عزيز… بآبائهم. يفخر
أفاقوا على صرخة النائبات
يُرجعُها القدر المنذر
أفاقوا… إلى حيث لا يعرفون
يضمُهُمُ السَّيْسَبَ المُقْفر
لقد شاء هذا الزمانُ المُشِتُ
بأن يستَتَارُوا، وأن يُقهَرُوا
تلاميذ في عصفة الكارثات
على هجر أوطانهم أجبروا
إلى أن تلاقوا هنا.. في الخيام
يضمُّهُمُ الهدف الأكبر
فقد علموا من دروس الفتاة
بأن لا يذلوا وأن يصبر
وا تقول لهم، وهي تلقي الدروس
وأعينهم نحوها تَنْظُرُ
أحياء روحي لا تيأسواء
ولو شمل العالم المنكر
وكونوا كفجر الحياة الوضي
يُداعية الأمل النير
صغاري: غد لكم، فاعْمَلُواء
على خير أوطانكُمْ تُنْصَرُوا
أحياء روحي أنا شمعة
تُضِي ولكنّها تُصْهَرُ
تقول وأطفالها يُنْشِدُونَ.
وإن كررت قولها كرروا
هارون هاشم رشید
المجموعة الشعرية الكاملة دار العودة بيروت
1981
تقديم القصيدة:
قصيدة عمودية وصفية نظمت وفق تفعيلة بحر المتقارب
ذات طابع سياسي للشاعر الفلسطيني المعاصر
للشاعر الفلسطيني هاورن هاشم رشيد هذه القصيدة مقتطف من مجموعته الشعرية الكاملة
قصيدة "معلمة لاجئة" للشاعر هارون هاشم رشيد هي عمل مؤثر يجسد معاناة اللاجئين وتضحياتهم. الشاعر يسرد قصة معلمة لاجئة تتحدى الظروف القاسية لتعلم طلابها الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين. يتحدث عن ألم الفراق والوطن المسلوب، ولكن أيضًا عن الأمل والإصرار على الصمود والمثابرة.
القصيدة تلهم بالقوة والشجاعة، وتعكس التزام المعلمة بتعليم الأجيال الصاعدة رغم كل الصعوبات. فعلاً، الأدب له قدرة سحرية على نقل المشاعر والتجارب الإنسانية بأروع الصور.
:موضوع القصيدة
معاناة الاطفال الفلسطنين في الملاجئ و دور المعلمة
في مواساتهم و حثهم علي الصمود و الكفاح من اجل حرير الوطن
:تقسيم القصيدة
المقاطع
حسب معيار الضمائر
من ب 1 الي ب 6 // ضمير الغايب الؤنث هي
من ب 7 الي ب 14 – ضمير الغائب هم
البقية // ضميرا الغائب عي + هم
1- اشرح الكلمات الآتية حسب السياق الذي وردت فيه (الوجنة - المقلة - الأسى - لوعة)
شرح الكلمات حسب السياق الذي وردت فيه في القصيدة:
- الوجنة: يقصد بها الخد، وهو الجزء البارز من الوجه بين العين والفم. في القصيدة، يشير إلى احمرار الخدين بسبب البرد أو العواطف الجياشة.
- المقلة: تعني العين، وهي الجزء الذي يُبصر به الإنسان. في القصيدة، تُستخدم للتعبير عن النظرات والرؤى التي تشهدها المعلمة.
- الأسى: يعني الحزن الشديد والشعور بالألم. في القصيدة، يُستخدم لوصف مشاعر الحزن والأسى التي تنتاب المعلمة وطلابها في مخيم اللاجئين.
- لوعة: تعني الألم الشديد والشوق، وغالبًا ما يُرافقها الحزن أو الحنين. في القصيدة، يُستخدم لوصف الألم العميق والشوق الذي يشعر به اللاجئون
- بسبب فراق وطنهم.
2- في القصيدة ثلاثة أصوات و ثلاثة ضمائر. قطع القصيدة وفق ذلك
- الصوت الأول (الراوي):
- الضمير الثالث: يقوم الراوي بسرد الأحداث والوصف من وجهة نظر خارجية.
- على سبيل المثال:
- "مع الفجر، راقبتها تعبر
- على وجنتيها احمرار يذوب
- وفي مقلتيها، رؤى تنحر"
- الصوت الثاني (المعلمة):
- الضمير المتكلم: عندما تتحدث المعلمة إلى الأطفال وتلقي الدروس.
- على سبيل المثال:
- "أحياء روحي لا تيأسواء
- ولو شمل العالم المنكر
- وكونوا كفجر الحياة الوضي
- يُداعية الأمل النير"
- الصوت الثالث (التلاميذ):
- الضمير الثاني: عندما يتحدث التلاميذ ويكررون كلمات المعلمة.
- على سبيل المثال:
- "تقول وأطفالها يُنْشِدُونَ.
- وإن كررت قولها كرروا"
هذا التقسيم يظهر تداخل الأصوات والضمائر في القصيدة مما يضيف لعمق النص وتأثيره.
3- حدد وحدة الوزن (التفعيلية) في القصيدة اذكر مجموعة اخرى من القصائد على نفس التفعيلة
حدد وحدة الوزن (التفعيلية) في القصيدة اذكر مجموعة اخرى من القصائد على نفس التفعيلة
القصيدة تتبع بحر الطويل، وهو أحد بحور الشعر العربي المعروف بالأصالة والشيوع. يتكون الوزن (التفعيلة) في بحر الطويل من التفعيلات التالية:
- فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
لذا، نجد في كل بيت من أبيات القصيدة تكرارًا لهذه التفعيلات.
مجموعة أخرى من القصائد على نفس التفعيلة:
- قصيدة "ألا في سبيل المجد" لأبي تمام
- قصيدة "الخير في الناس مصنوع" لإيليا أبو ماضي
- قصيدة "لامية العرب" للشنفرى
- قصيدة "أغنية إلى الدهر" لأحمد شوقي
بحر الطويل هو واحد من البحور الشعرية الجميلة التي تتيح للشعراء مساحة كبيرة للتعبير والتفنن. إذا كنت بحاجة لمزيد من التفاصيل أو دراسة قصائد معينة، فلا تتردد في السؤال.
4- اقرا البيتين (10 و11) مرة بظم الميم الأخيرة في كلمة يضمهم الواردة في عجزي البيتين ، ومرة بتسكينها ايهما اصح من حيث الوزن
- بضم الميم:
إلى أن تلاقوا هنا.. في الخياميضمُّهُمُ الهدف الأكبرفقد علموا من دروس الفتاةبأن لا يذلوا وأن يصبر
- بتسكين الميم:
إلى أن تلاقوا هنا.. في الخياميضمْهمُ الهدف الأكبرفقد علموا من دروس الفتاةبأن لا يذلوا وأن يصبرعند النظر إلى التفعيلة المستخدمة (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن) يمكننا ملاحظة أن ضم الميم في كلمة "يضمهم" يحافظ على الوزن الصحيح للبيت. بينما تسكين الميم يخل بالتفعيلة والوزن.
إذاً، القراءة الصحيحة للبيتين يجب أن تكون بضم الميم في كلمة "يضمهم" للحفاظ على الوزن الشعري الصحيح.
5- ابحث في كتب التاريخ عن اسباب تحول الشعب الفلسطيني إلى شعب لاجئ
تحول الشعب الفلسطيني إلى شعب لاجئ نتيجة لعدة عوامل تاريخية وسياسية. في العصر العثماني، تعرضت فلسطين لتدفقات هجرية كبيرة بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الدول المجاورة. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، تعرضت فلسطين لتدفقات هجرية جديدة بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية في أوروبا.
ومع اندلاع النكبة في عام 1948، تعرض الشعب الفلسطيني لتدفقات هجرية كبيرة نتيجة للنزاعات العربية-إسرائيلية والتي أدت إلى تشريد وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين. ومنذ ذلك الحين، استمر الشعب الفلسطيني في الهجرة نتيجة للنزاعات والحرب والتهجير القسري من طرف جيش الاحتلال الاسرائيلي .
ابني المعنى:
1- استخلص من الإطار الزماني لوصف المعاناة أهم خصال المرأة المناضلة
أهم خصال المرأة المناضلة من الإطار الزماني لوصف المعاناة في القصيدة:
- الصبر والصمود: المرأة المعلمة تظهر قدرة عظيمة على التحمل والصبر في وجه الظروف القاسية. فهي تستيقظ مع الفجر وتواجه البرد والمشاق لتعليم تلاميذها.
<>2.مع الفجر، راقبتها تعبر<>3.على وجنتيها احمرار يذوب"
- العطاء والتضحية: تعطي نفسها بالكامل لأجل تلاميذها، حيث تعمل في ظروف صعبة وتتحدى الألم والجوع لتوفر لهم العلم والأمل.
<>5.أحياء روحي أنا شمعة<>6.تُضِي ولكنّها تُصْهَرُ"
- الشجاعة والقوة: تصر على مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتعلم تلاميذها القيم النبيلة مثل الكرامة والشجاعة.
<>8.وا تقول لهم، وهي تلقي الدروس<>9.وأعينهم نحوها تَنْظُرُ"
- الإصرار والإيمان بالأمل: تُلهم تلاميذها وتحثهم على العمل والمثابرة لتحقيق مستقبل أفضل، مهما كانت الصعوبات.
<>11.أحياء روحي لا تيأسواء<>12.ولو شمل العالم المنكر"هذه الخصال تجعل من المعلمة رمزاً للمرأة المناضلة التي تواجه الصعاب بكل شجاعة وتضحية وإيمان بالأمل.
2- ما دلالة الاستفهام في المقطع الأول
في المقطع الأول من القصيدة، يستخدم الشاعر الاستفهام المتكرر "إلى أين؟" ليعبر عن مشاعر الحيرة والقلق التي تكتنف الراوي تجاه المعلمة اللاجئة. دلالة هذا الاستفهام متعددة الأوجه:
- التشديد على حالة الضياع وعدم اليقين: تكرار السؤال "إلى أين؟" يعكس حالة عدم اليقين التي تعيشها المعلمة، والتي تمثل بدورها معاناة الشعب الفلسطيني الذي اضطر للنزوح وترك وطنه. هذا التساؤل يجسد البحث عن الأمل والمستقبل في ظل ظروف قاسية وغير مستقرة.
- إبراز الغموض والإثارة: الاستفهام يخلق جوًا من الغموض حول وجهة المعلمة وهدفها المبكر قبل انبلاج الصباح. هذا يدفع القارئ إلى التعمق في القصيدة ومحاولة فهم دوافع المعلمة وما تحمله من رسائل.
- التعبير عن القلق والتعاطف: التساؤلات تعكس قلق الراوي وربما المجتمع تجاه المعلمة وما قد تواجهه. هي ليست مجرد أسئلة، بل تعبير عن مشاعر إنسانية بالاهتمام والتعاطف مع من يعانون.
- الرمز للرحلة النضالية: "إلى أين؟" قد ترمز أيضًا إلى رحلة النضال المستمرة التي يقوم بها الفلسطينيون. المعلمة تمثل رمزًا للصمود والمثابرة، وتساؤلات الراوي تعكس التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق رسالتها.
- تجسيد الحالة النفسية: الاستفهام المتكرر يمكن أن يكون انعكاسًا لحالة المعلمة النفسية نفسها، حيث تتساءل في داخلها عن الطريق والمصير، لكنها مع ذلك تستمر في السير بخطى ثابتة.
باختصار، دلالة الاستفهام في المقطع الأول تتجاوز المعنى الظاهري للسؤال. هو أداة شعرية قوية يستخدمها الشاعر للتعبير عن عمق المعاناة الإنسانية، والقلق من المجهول، والإصرار على المضي قدمًا رغم كل العوائق. الاستفهام هنا يثري النص بأبعاد فلسفية وعاطفية، ويضع القارئ أمام تساؤلات وجودية حول الغاية والوجهة والأمل في أوقات المحن.
3- حلل الصورة الشعرية الواردة في عجز البيت الثاني مبيناً دورها في الكشف عن واقع المرأة الفلسطينية
في عجز البيت الثاني من القصيدة، يقول الشاعر:
"راقبتها تعبر"
هذه العبارة تحمل صورة شعرية مؤثرة تعكس الكثير من المعاني والدلالات حول واقع المرأة الفلسطينية.
تحليل الصورة الشعرية:
- "راقبتها تعبر":
- المراقبة: تشير إلى اهتمام الشاعر أو الراوي بالمعلمة، حيث يلاحظ تفاصيل حركتها وتصرفاتها. هذا يعكس أهمية دورها ورمزية شخصيتها في المجتمع.
- "تعبر":
- الحركة والتنقل: الكلمة تدل على الانتقال من مكان إلى آخر، وهنا يمكن أن تكون عبورًا ماديًا للطريق أو المسافات.
- التجاوز والتخطي: "تعبر" تحمل أيضًا معنى تجاوز الصعاب والعقبات، فهي لا تمر فقط بمكان، بل تتخطى الحواجز النفسية والجسدية.
- الدلالة الرمزية:
- تجسيد للمعاناة والصمود: الحركة في وقت الفجر وفي ظل الظروف القاسية ترمز إلى قوة الإرادة والتصميم لدى المرأة الفلسطينية.
- الاستمرارية والأمل: العبور هنا ليس مجرد فعل، بل رحلة نحو المستقبل، تحمل في طياتها الأمل بالتغيير والتحسين.
دور الصورة في الكشف عن واقع المرأة الفلسطينية:
- التحدي والمثابرة:
- تعكس الصورة إصرار المرأة الفلسطينية على أداء دورها الريادي في المجتمع، رغم كل التحديات التي تواجهها.
- المعلمة تُ symbolizes المرأة التي تتحمل المسؤولية مضاعفة؛ فهي ترعى الأجيال الناشئة وتبث فيهم الأمل والقيم.
- التضحية والعطاء:
- عبورها في الفجر وقبل انبلاج الصباح يُظهر تضحيتها بوقتها وراحتها من أجل الآخرين.
- هي نموذج للتفاني، حيث تضع مصلحة تلاميذها ووطنها فوق مصلحتها الشخصية.
- الأمل والتطلع للمستقبل:
- الحركة باتجاه معين ترمز إلى السعي نحو مستقبل أفضل.
- تعبر عن الأمل المستمر بالرغم من الواقع المرير، وأن المرأة الفلسطينية هي نبراس يضيء الطريق للآخرين.
الخلاصة:
الصورة الشعرية في "راقبتها تعبر" ليست مجرد وصف لحركة جسدية، بل هي رمز قوي يعكس واقع المرأة الفلسطينية المناضلة. الشاعر يُبرز من خلالها صفات مثل القوة، الصمود، التضحية، والأمل. هذه الصورة تُظهر كيف أن المرأة، بالرغم من كل الصعوبات، تظل ركيزة أساسية في بناء المجتمع والحفاظ على الهوية والتراث.
من خلال هذه الصورة، يُقدم الشاعر تحية إجلال وإكبار للمرأة الفلسطينية، ويُذكرنا بدورها المحوري في نقل الرسالة والاستمرار في رحلة النضال نحو الحرية والكرامة.
4- استخرج من النص ما يؤكد معاناة الطفل والمرأة الفلسطينيين في مخيمات الشتات
من خلال النص يمكن استخراج العديد من الأبيات التي تؤكد معاناة الطفل والمرأة والفلسطينيين في مخيمات الشتات:
1. معاناة الأطفال:
- "تعَذِّبُ في البرد أجسامهم وأقدامهم من دم تقطر"
- التفسير: يصف الشاعر حالة الأطفال الذين يعانون من البرد الشديد، حيث تؤلمهم أجسادهم من قسوة الطقس، وتسيل الدماء من أقدامهم بسبب السير حُفاةً أو لعدم توفر الأحذية المناسبة. هذا المشهد يجسد المعاناة الجسدية التي يواجهها الأطفال في المخيمات.
- "تلاميذ في عصفة الكارثات على هجر أوطانهم أجبروا"
- التفسير: يشير الشاعر إلى أن هؤلاء التلاميذ الصغار تعرضوا لكوارث كبيرة أجبرتهم على مغادرة أوطانهم. هذا يعكس المعاناة النفسية والصدمة التي يعيشها الأطفال بسبب التهجير القسري.
- "أفاقوا على صرخة النائبات يُرجعُها القدر المنذر"
- التفسير: استيقظ الأطفال على أصوات المصائب والكوارث، مما يدل على الحالة المأساوية والظروف القاسية التي تحيط بهم، حيث يصبح الخوف والقلق جزءًا من حياتهم اليومية.
2. معاناة المرأة (المعلمة):
- "تكاد، دموع الأسى تَطْفِرُ"
- التفسير: تصف هذه العبارة المعلمة التي تكاد دموعها تنهمر من شدة الحزن والأسى. هذا يعكس المعاناة العاطفية التي تعيشها، وكيف أنها تُخفي ألمها خلف قوتها الظاهرة لتستمر في دعم تلاميذها.
- "أحياء روحي أنا شمعة تُضِيء ولكنّها تُصْهَرُ"
- التفسير: تُشَبِّهُ المعلمة نفسها بشمعة تُضيء للآخرين بينما تذوب هي. هذا التشبيه يُبرز تضحيتها الكبيرة، حيث تُقدم كل ما لديها من أجل تعليم الأطفال ورعايتهم، رغم ما تتكبده من مشقة ومعاناة.
- "مع الفجر، راقبتها تعبر على وجنتيها احمرار يذوب وفي مقلتيها، رؤى تنحر"
- التفسير: يظهر الشاعر المعلمة وهي تعبر في وقت الفجر، وعلامات التعب والحزن بادية على وجهها. الاحمرار الذي يذوب على وجنتيها قد يكون نتيجة البرد أو السهر، أما "رؤى تنحر" فتعكس الأحلام والآمال التي تتلاشى بسبب الواقع المرير.
3. معاناة الفلسطينيين في مخيمات الشتات:
- "لقد شاء هذا الزمانُ المُشِتُ بأن يستَتَارُوا، وأن يُقهَرُوا"
- التفسير: يوضح الشاعر أن الزمن القاسي فرض على الفلسطينيين التشتت والقهر. هذا البيت يجسد الظلم والمعاناة الجماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الظروف السياسية والاجتماعية.
- "إلى أن تلاقوا هنا.. في الخيام يضمُّهُمُ الهدف الأكبر"
- التفسير: تجمع الفلسطينيون في المخيمات، حيث يعيشون في خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة. ورغم ذلك، يجمعهم الأمل والهدف المشترك بالعودة إلى أوطانهم.
- "تلاميذ كان لهم موطن عزيز… بآبائهم يفخر"
- التفسير: يذكّر الشاعر بأن هؤلاء الأطفال كانوا يمتلكون وطنًا عزيزًا يفخرون به وبآبائهم. الفقدان الذي يشعرون به يعكس الحنين والألم الناتج عن التهجير والابتعاد عن الوطن.
- "يضمُهُمُ السَّيْسَبَ المُقْفر"
- التفسير: "السيسب المقفر" تعبير عن المكان القاحل والمهجور. الشاعر يشير إلى البيئة الصعبة والقاسية التي يعيش فيها الفلسطينيون في المخيمات، والتي تفتقر إلى الحقول الخضراء والبيوت الدافئة.
هذه الاقتباسات والتفاسير تسلط الضوء على حجم المعاناة التي يواجهها الأطفال والمرأة والفلسطينيون عمومًا في مخيمات الشتات. الشاعر هارون هاشم رشيد نجح في تصوير الألم والظروف القاسية بأسلوب شعري مؤثر، مع التركيز على القوة والصمود والإرادة في مواجهة التحديات. القصيدة تُبْرِزُ أيضًا أهمية التعليم والأمل كمصادر للقوة والتغيير في ظل هذه الظروف الصعبة.
5- يبين من النص كيف تساهم المرأة الفلسطينية في رفع الضيم عن شعبها الأعزل
من خلال قصيدة "معلمة لاجئة" للشاعر هارون هاشم رشيد، تظهر المرأة الفلسطينية كرمز للقوة والصمود والتضحية في وجه الظلم والاضطهاد. تساهم هذه المرأة، المتمثلة في شخصية المعلمة اللاجئة، في رفع الضيم عن شعبها الأعزل بطرق متعددة، ويمكن توضيح ذلك من النص كما يلي:
1. التضحية والعطاء المستمر:
تبدأ القصيدة بوصف المعلمة وهي تستيقظ قبل الفجر، متحملة البرد والتعب، لتصل إلى تلاميذها في المخيمات:
> "مع الفجر، راقبتها تعبر > على وجنتيها احمرار يذوب > وفي مقلتيها، رؤى تنحر"
- التفسير: تُضحي المعلمة براحتها وصحتها من أجل تعليم الأطفال، حيث يظهر احمرار وجنتيها كدليل على الإرهاق أو البرد. هذه التضحية الشخصية تعكس مدى التزامها بتحقيق مستقبل أفضل لأبنائها وشعبها.
2. التعليم كسلاح للتمكين والتحرر:
تُدرك المعلمة أهمية العلم كوسيلة لتحرير شعبها من الضيم والظلم:
> "وا تقول لهم، وهي تلقي الدروس > وأعينهم نحوها تَنْظُرُ > أحياء روحي لا تيأسوا > ولو شمل العالم المنكر"
- التفسير: تحفز المعلمة تلاميذها على التمسك بالأمل وعدم اليأس، مهما كانت الظروف صعبة. بتعليمها لهم، تزودهم بالأدوات الفكرية والمعرفية التي تمكنهم من مواجهة التحديات المستقبلية.
3. بث روح الأمل والصمود:
تعمل المعلمة على غرس قيم الصبر والصمود في نفوس التلاميذ:
> "صغاري: غد لكم، فاعملوا > على خير أوطانكم تُنصروا"
- التفسير: تدعو المعلمة إلى العمل من أجل الوطن، مشجعةً الأطفال على الإيمان بأن المستقبل سيكون أفضل بجهودهم ومثابرتهم.
4. القدوة الحسنة والتأثير الإيجابي:
تقدم المعلمة نفسها كنموذج للتفاني والتضحية:
> "أحياء روحي أنا شمعة > تُضِيء ولكنّها تُصْهَرُ"
- التفسير: تشبه نفسها بالشمعة التي تضيء للآخرين رغم أنها تذوب وتفنى. هذا التشبيه يُبرز مدى تضحيتها ورغبتها في منح الضوء والأمل للآخرين، حتى لو كان ذلك على حساب راحتها.
5. تعزيز الوحدة والهوية الوطنية:
تركز المعلمة على تذكير التلاميذ بأصولهم وهويتهم:
> "تلاميذ كان لهم موطن > عزيز… بآبائهم يفخر"
- التفسير: تُذكّر الأطفال بماضيهم المجيد ووطنهم العزيز، لتعزيز شعور الانتماء والاعتزاز بالهوية الفلسطينية، مما يساعدهم على مواجهة محاولات التهميش والإقصاء.
6. المواجهة والتحدي للظروف الصعبة:
تُظهر المعلمة قوة في مواجهة الظلم والقهر:
> "لقد شاء هذا الزمانُ المُشِتُ > بأن يستتاروا، وأن يُقهَرُوا"
- التفسير: رغم إدراكها للتحديات والمعاناة المفروضة على شعبها، إلا أنها لا تستسلم. بل تُصر على الاستمرار في رسالتها التعليمية والتربوية.
7. التواصل والتضامن المجتمعي:
تُساهم المعلمة في بناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع في المخيمات:
> "إلى أن تلاقوا هنا.. في الخيام > يضمُّهُمُ الهدف الأكبر"
- التفسير: تساعد في جمع التلاميذ وتعزيز الروابط بينهم، موحدةً إياهم تحت هدف مشترك هو الصمود والتحرر.
الخلاصة:
تُسهم المرأة الفلسطينية، ممثلةً في المعلمة اللاجئة، في رفع الضيم عن شعبها الأعزل من خلال:
- التضحية الشخصية: تقديم راحتها وصحتها في سبيل تعليم الأطفال.
- التمكين بالتعليم: تزويد الأجيال بالمعرفة والوعي لمواجهة الظلم.
- بث الأمل والصمود: تشجيع التلاميذ على عدم اليأس والإيمان بالمستقبل.
- القدوة الحسنة: تقديم نموذج يُحتذى به في التفاني والعمل الوطني.
- تعزيز الهوية والوحدة: تذكير الجيل الجديد بأصولهم وقيمهم الوطنية.
- التحدي والمواجهة: عدم الاستسلام للظروف القاسية والسعي للتغيير.
- بناء التضامن المجتمعي: توحيد الجهود وغرس روح الجماعة.
من خلال هذه الأدوار المتعددة، تَبني المرأة الفلسطينية أساسًا قويًا لمجتمعها يمكنه من مقاومة الظلم واستعادة حقوقه. تُظهر القصيدة كيف أن التعليم والأمل والعمل الجماعي هي أدوات رئيسية في يد المرأة لرفع الضيم عن شعبها والدفاع عن قضيته العادلة.
أبدي رأيي:
1- إلى أي حد تعكس القصيدة دور المرأة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال؟ أيد رأيك بوقائع ملموسة
القصيدة "معلمة لاجئة" للشاعر هارون هاشم رشيد تعكس بشكل عميق دور المرأة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال، من خلال تصوير شخصية المعلمة اللاجئة التي تمثل رمزًا للصمود والتحدي والتضحية. القصيدة تقدم رؤية شاملة لكيفية مساهمة المرأة في النضال الوطني، وذلك عبر وسائل متعددة. إليك تحليلًا يوضح مدى انعكاس دور المرأة في المقاومة، مدعومًا بوقائع ملموسة:
1. التعليم كسلاح للمقاومة والحفاظ على الهوية:
- في القصيدة:
> "تعَذِّبُ في البرد أجسامهم > وأقدامهم من دم تقطر > تلاميذ كان لهم موطن > عزيز… بآبائهم يفخر"
المعلمة تبذل جهدًا كبيرًا لتعليم الأطفال رغم الظروف القاسية في المخيمات. تُدرك أهمية التعليم في تعزيز الوعي الوطني والحفاظ على الهوية الفلسطينية.
- وقائع ملموسة:
- نشر الوعي الوطني: لعبت المرأة الفلسطينية دورًا محوريًا في تعليم الأجيال الناشئة، خاصة في مخيمات اللجوء، حيث أنشأت مدارس سرية وعلنية للحفاظ على اللغة والثقافة والتراث.
- محو الأمية: أسهمت جهود المعلمات والمتطوعات في محو الأمية بين النساء والأطفال، مما عزز من قوة المجتمع الفلسطيني في مواجهة محاولات التجهيل.
2. التضحية والصمود في وجه المعاناة:
- في القصيدة:
> "أحياء روحي أنا شمعة > تُضِيء ولكنّها تُصْهَرُ"
تشبه المعلمة نفسها بالشمعة التي تنير للآخرين رغم أنها تذوب، مما يرمز إلى تضحيتها الذاتية من أجل مستقبل شعبها.
- وقائع ملموسة:
- المشاركة في الانتفاضات: كانت النساء في مقدمة المشاركين في الانتفاضة الأولى والثانية، مقدمات الرعاية والدعم للمقاومين.
- الأسر والشهادة: تعرضت العديد من النساء للسجن والاستشهاد، مثل ميّ عافية وأحلام التميمي، تأكيدًا على استعدادهن للتضحية القصوى.
3. بث الأمل والتحفيز على المقاومة:
- في القصيدة:
> "أحياء روحي لا تيأسوا > ولو شمل العالم المنكر > وكونوا كفجر الحياة الوضي > يُداعبه الأمل النير"
تحث المعلمة تلاميذها على التمسك بالأمل والعمل للمستقبل رغم الصعاب.
- وقائع ملموسة:
- العمل الاجتماعي والتنموي: أنشأت النساء جمعيات ومؤسسات تُعنى بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مثل اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
- تنظيم الحملات والمظاهرات: قادت النساء مسيرات سلمية وفعاليات احتجاجية دولية لإبراز معاناة الشعب الفلسطيني والمطالبة بحقوقه.
4. المحافظة على التراث والهوية الثقافية:
- في القصيدة:
> "تلاميذ كان لهم موطن > عزيز… بآبائهم يفخر"
تعمل المعلمة على غرس الفخر بالوطن والقيم التراثية في نفوس الأطفال.
- وقائع ملموسة:
- الحفاظ على الفن والتراث: نظمت النساء معارض للأشغال اليدوية والتطريز الفلسطيني، مثل جمعية إنعاش الأسرة، للحفاظ على التراث والتعريف به عالميًا.
- تدريس التاريخ والثقافة: عملت النساء كمدرسات ومربيات لنقل القصص والتاريخ الفلسطيني للأجيال الجديدة، مما ساهم في تعزيز الهوية الوطنية.
5. المشاركة السياسية والنضالية المباشرة:
- في القصيدة:
> "فقيل لها في شقوق الخيام > تلاميذ، من أجلها بُكِّرُوا > تَعَذِّبُ في البرد أجسامهم > وأقدامهم من دم تقطر"
يظهر التزام المعلمة تجاه تلاميذها وقضيتها، متحديةً الظروف القاسية.
- وقائع ملموسة:
- الانخراط في الحركات السياسية: انضمت النساء إلى الصفوف الأمامية في الفصائل والحركات الفلسطينية، مثل خيرية أبو حاشية وليلى خالد، التي أصبحت رمزًا عالميًا للنضال.
- التمثيل الدبلوماسي: شاركت النساء في التمثيل الفلسطيني على الساحة الدولية، ساعيات لكسب الدعم والتأييد للقضية، مثل حنان عشراوي.
6. تعزيز الوحدة والتضامن المجتمعي:
- في القصيدة:
> "إلى أن تلاقوا هنا.. في الخيام > يضمُّهُمُ الهدف الأكبر"
تسهم المعلمة في توحيد تلاميذها حول هدف مشترك، مما يعزز من تماسك المجتمع.
- وقائع ملموسة:
- تنظيم المبادرات المجتمعية: أسهمت النساء في تنظيم مبادرات تعاونية داخل المخيمات، لتقديم المساعدات والمساندة للأسر المحتاجة.
- دور المرأة في الأسرة: بالاستمرار في تقديم الرعاية والدعم داخل الأسرة، حافظت المرأة على تماسك النسيج الاجتماعي، مما ساعد المجتمع على الصمود.
الخلاصة:
القصيدة ليست مجرد تصوير لمعاناة المعلمة أو الأطفال، بل هي تجسيد لدور المرأة الفلسطينية كعمود فقري في مقاومة الاحتلال. من خلال التعليم، التضحية، بث الأمل، المحافظة على التراث، المشاركة السياسية، وتعزيز الوحدة، أثبتت المرأة الفلسطينية دورها الفعال والحاسم في النضال من أجل الحرية والكرامة.
الوقائع التاريخية تؤكد هذا الدور، حيث لم تقتصر مساهمات المرأة على جانب واحد، بل تعددت وتنوعت لتشمل مختلف ميادين العمل الوطني. القصيدة تعكس هذه الأبعاد بعمق وصدق، مسلطة الضوء على التحديات والإنجازات التي حققتها المرأة الفلسطينية في سبيل قضيتها العادلة.
من هو هارون هاشم رشيد؟
هارون هاشم رشيد (1927 - 27 يوليو/تموز 2020) هو شاعرٌ فلسطيني من مواليد حارة الزيتون بمدينة غزة، وهو من شعراء الخمسينات ممن أطلق عليهم شعراء النكبة أو شعراء العودة. يمتاز شعره بروح التمرد والثورة ويعد من أكثر الشعراء الفلسطينيين استعمالاً لمفردات العودة حتى أطلق عليه الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة لقب (شاعر القرار 194) [قرار الأمم المتحدة حول حق العودة].
أصدر عشرين ديواناً شعرياً، وشغل منصب مندوب فلسطين المناوب بجامعة الدول العربية. وهو حاصل على وسام القدس للثقافة والفنون والآداب من الرئيس الفلسطيني عام 2016، واختير كشخصية العام الثقافية من قبل وزارة الثقافة الفلسطينية عام 2014، وحائز على وسام القدس للعام 1990.
حياته
درس هارون هاشم رشيد في مدارس غزة فأنهى دراسته الثانوية في العام 1947، وحصل على شهادة المعلمين العليا. وعمل بعد حصوله على الدبلوم العالي لتدريب المعلّمين من كليّة غزة في سلك التعليم حتى عام 1954.
انتقل للعمل في المجال الإعلامي فتولّى رئاسة مكتب إذاعة «صوت العرب» المصرية في غزة عام 1954 لعدة سنوات، وعندما أُنشئت منظمة التحرير الفلسطينية كان مشرفاً على إعلامها في قطاع غزة من عام 1965 إلى 1967.
بعد سقوط غزة في أيدي الإسرائيليين عام 1967 ضايقته قوات الاحتلال وأجبرته في النهاية على الرحيل من قطاع غزة. فانتقل إلى القاهرة وعُيّن رئيساً لمكتب منظمة التحرير فيها، ثم عمل لثلاثين عاماً مندوباً دائماً لفلسطين في اللجنة الدائمة للإعلام العربي واللجنة الدائمة للشؤون المالية والإدارية بالجامعة العربية. إضافة إلى ذلك واصل عمله الإبداعي في الكتابة والصحافة والتأليف والشعر.
عاصر الشاعر هارون هاشم رشيد الاحتلال ومعاناة الغربة وشاهد بأم عينيه جنود الجيش البريطاني قبل الإسرائيلي يهدمون المنازل ويقتلون العُزّل والأطفال والنساء والشيوخ حتى أصبحت تلك المشاهد هي الصورة اليومية لحياة المواطن الفلسطيني. من رحم هذه المحن وتلك العذابات أطلق هارون هاشم رشيد عهده في النضال حتى آخر بيت شعر، فتغنى بالشهداء وافتخر بالمعتقلين الشرفاء، ووقف مع المقاتلين من أجل استرجاع الحقوق الفلسطينية من قبضة الاحتلال.
يعبّر شعره عن مأساة الفلسطينيين الذين اقتلعوا من أرضهم وبيوتهم زديارهم، ويصف عذابهم ومشاعر الفقدان والاغتراب العميقة التي عايشوها عبر السنين. أطلقت عليه ألقاب مختلفة مستوحاة من مراحل عذابات شعبه، فهو «شاعر النكبة»، و«شاعر العودة»، ز«شاعر الثورة» وهو لقبٌ أطلقه عليه الشهيد خليل الوزير عام 1967 بعد قصيدته «الأرض والدم»، وأطلق عليه الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة لقب (شاعر القرار 194) قرار حق العودة.
أصدر قرابة عشرين ديواناً شعريّاً منها «الغرباء» 1954، و«عودة الغرباء» 1956، «غزة في خط النار»، «حتى يعود شعبنا» 1965، «سفينة الغضب» 1968، «رحلة العاصفة» 1969، «فدائيون» 1970، «مفكرة عاشق» 1980، «يوميات الصمود والحزن» 1983، «ثورة الحجارة» 1991، «طيور الجنة» 1998، وغيرها.
قَدّمَ ما يقارب تسعين من قصائده الشعرية أعلام في الغناء العربي، وفي مقدمة من شدوا بأشعاره فيروز، وفايدة كامل، ومحمد فوزي، وكارم محمود، ومحمد قنديل، ومحمد عبده، وطلال مداح، وآخرون.
كتب أيضاً أربع مسرحياتٍ شعريةٍ، مُثِل منها علي المسرح في القاهرة مسرحية «السؤال» من بطولة كرم مطاوع وسهير المرشدي. وبعد حرب العبور 1973 كتب مسرحية «سقوط بارليف» وقٌدمت على المسرح القومي بالقاهرة عام 1974، ومسرحية «عصافير الشوك»، إضافة إلى العديد من المسلسلات والسباعيات التي كتبها لإذاعة «صوت العرب» المصرية وعدد من الإذاعات العربية.
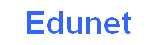





 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
