بحث جاهز حول الخوف عند الاطفال
1 - المقدمة :
من بين الانفعالات التي يعيشها الإنسان في حياته يعتبر الخوف واحداً من أكثرها شيوعاً وتثيره موافق عديدة لا حصر لها، والتي تتباين تبايناً كبيراً في حياة مختلف الأفراد، كما تتنوع شدته من مجرد الحذر إلى الهلع والرعب، ويعتبر الخوف إحدى القوى التي قد تعمل على البناء أو على الهدم في تكوين الشخصية ونموها[1].
وقد كان العلماء يعتقدون أن الطفل يولد مزوداً بغريزة الخوف، لكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الخوف عند الطفل لا يبدأ قبل الشهر السادس، ولا يكون في هذه السن واضحاً أو محدداً، وأكثر ما يبدو ذلك بتأثير الأصوات العالية، وإضاعة التوازن[2].
وتعتبر السنوات الأولى في حياة الفرد من أهم الفترات، بل هي الدعامة الأساسية التي تقوم عليها حياته النفسية والاجتماعية، وفي خلالها يتقرر ما إذا كان سينشأ على درجة معقولة من الأمن والطمأنينة، أو سيعاني من القلق النفسي والخوف، ذلك لأن أية خبرة نفسية وجدانية مخيفة يصادفها الإنسان في طفولته تسجل في نفسه وتظل هائمة فيها، وقد يستعيدها لاشعورياً في كبره فيشعر بالخوف، وقد يسقط مشاعرها على المواقف والخبرات المشابهة فيخاف[3].
والمخاوف المعقولة جزء طبيعي من الحياة، وكل طفل يتعلم طائفة معينة من المخاوف، وبعض هذه المخاوف تساعد على حفظ الذات مما يدفع الطفل إلى تجنب الأخطار المرتبطة بها، وقد تكون هذه المخاوف أساساً لتعلم أمور جديدة (كالخوف من السيارة المسرعة أو الخوف من بعض الحيوانات المؤذية).
إلا أن المخاوف الشديدة والكثيرة الانتشار والتكرار والتي ترتبط بأنماط سلوكية معينة (كالبكاء والانسحاب والتماس المساعدة...) لا تتفق ولا تتناسق مع السلوك المتزن الفعال، وقد تكون بعض مخاوف الأطفال من هذا النوع، وبذلك يمكن أن تكون أكبر عائق يقف في سبيل نموهم الصحي[4].
2 - تعريف الخوف :
هناك تعاريف عديدة للخوف وسنكتفي بهذه التعاريف :
"الخوف إشارة تهدف إلى الحفاظ على الذات، وذلك بتعبئة الإمكانات الفيسيولوجية للكائن الحي"[5].
"الخوف حالة انفعالية طبيعية تشعر بها كل الكائنات الحية في بعض المواقف... فيظهر في أشكال متعددة وبدرجات تتراوح بين مجرّد الحذر والهلع والرعب"[6].
"الخوف هو انفعال قوي غير سار ينتج عن الإحساس بوجود خطرٍ ما وتوقّع حدوثه"[7].
3 - نمط الخوف :
يعدّ الخوف إشارة تهدف إلى الحفاظ على الذات، وذلك بتعبئته الإمكانات الفيزيولوجية للكائن الحي. إذ يبدأ الخوف على صورة نبض في الدماغ فينبه بدوره الأعصاب الودّية لتنبه مناطق مختلفة في الجلد وأعضاء مختلفة كالقلب والرئتين والأمعاء لتفرز علامات تدل على الخوف، مثل تعرق راحتي اليدين وخفقات القلب وتسرع النبض والتنفس وجفاف الحلق...الخ. والأعصاب الودية تؤدي عملها بواسطة مادة تسمى الأدرينالين، وهي تُفرز عند نهايات الأعصاب[8] الكائنة في الأعضاء المعينة. وإن الغدتين الأدرناليتين نفسيهما وهما تحت تأثير تنبيه أعصاب الود، تفرزان مادة أدرينالية إضافية في مجرى الدم لتزيد المادة الإضافية هذه من نشاط الأعصاب الودية.
فالصورة الكاملة للخوف تنطوي على جميع الأعراض التي يسببها الأدرينالين، وتنتج عنه والتي سبق ذكرها، ولا يشعر الفرد في العادة بما يقوم به الجسم من عمل وما يؤديه من وظائف، ذلك لأن الأعصاب نظيرة الودية تنظّم عمل الأعصاب الودية. وأنه فقط في الحالات غير الاعتيادية مثل حالات / الخوف - القلق - الغضب - الاستشارة / تتحكم الأعصاب الودية بالأعصاب نظيرة الودية فيشعر الفرد بوظيفة بعض الأعضاء[9].
4 - مخاوف الأطفال وكيفية تطورها :
لقد كان هناك شبه إجماع بين العلماء على أن من أهم المثيرات الأولى للخوف في الطفولة المبكرة هي الأصوات العالية الفجائية في السنة الأولى من عمر الطفل، خصوصاً عندما تكون الأم بعيدة عنه. وبتقدّم نمو الطفل تزداد مثيرات الخوف وتتنوع، ففي السنة الثانية وحتى الخامسة قد يفزع الطفل من الغرباء ومن الوقع من مكان مرتفع ومن الحيوانات والطيور التي لم يألفها، ويخاف من تكرار الخبرات المؤلمة التي مر بها - كالعلاج الطبي أو عملية جراحية - كما أنه يخاف مما يخاف منه من حوله من الكبار في البيئة التي يعيش فيها لأنه يقلدهم، فهو يتأثر بمخاوف الغير حتى لو لم تكن واقعية، وكانت وهمية أو خرافية.
ويظهر انفعال الخوف عند الطفل على أسارير وجهه في صورة فزع وقد يكون مصحوباً بالصراخ، ثم يتطور بعد السنة الثانية إلى الصياح والهرب المصحوب بتغيرات في خلجات الوجه أو الكلام المتقطع أو قد يكون مصحوباً بالعرق أو التبول اللاإرادي أحياناً، وتنتشر عدوى الخوف بين الأطفال كالنار في الهشيم.
ويمكن معرفة مدى خوف الطفل بمقارنة مخاوفه بمخاوف أغلب الأطفال الذين هم في مثل سنّه، وبمقارنة درجة هذه المخاوف بدرجة مخاوف أقرانه. فالطفل مثلاً في الثالثة من عمره يمكن أن يخاف من الظلام ويطلب إضاءة المكان، وربما كان خوفه هذا في حدود المعقول، أما إذا فقد الطفل اتزانه وأبدى فزعاً شديداً من الظلام فلا شك أنه خوف شاذ، وهذا النوع من الخوف مبالغ فيه، وهو ضار لشخصية الطفل وسلوكه، أما الخوف الطبيعي المعقول فهو مفيد لسلامة الطفل[10].
ويبدو بعض الأطفال خوافين بشكل عام، وبعضهم الآخر يخاف خوفاً محدداً من شيء أو شيئين، ولا تُظهِر معظم الدراسات وجود فروق في الخوف بين الأولاد والبنات.
إن حوالي نصف الأطفال على الأقل تظهر لديهم مخاوف مشتركة من الكلاب والظلام والرعب والأشباح وحوالي /10%/ من هؤلاء يعانون خوفاً شديداً من شيئين أو أكثر، والمخاوف الأكثر شيوعاً بين سنتين وست سنوات فيما بين سن السنتين والأربع سنوات تغلب المخاوف من الحيوانات والظلام والحيوانات والغرباء، وتقلّ هذه المخاوف عمر خمس سنوات ثم تختفي فيما بعد، وفي عمر /4/ إلى /6/ سنوات تسيطر المخاوف المتخيلة مثل الأشباح والوحوش، وتبلغ ذروتها في عمر /6/ سنوات ثم تختفي فيما بعد.
إن /90%/ من الأطفال تحت السادسة من العمر يظهر لديهم خوف محدد يزول بشكل طبيعي[11].
وبالرغم من أن طبيعة مخاوف الأطفال قد يعتريها التغير مع مرور الزمن، إلا أنه في جميع الحالات تعتبر المخاوف أساساً توقعاً لخطر أو لحدث غير سار، إلا أنها تتميز الواحدة منها عن الأخرى في بعض النواحي، فالخوف الواقعي بصورة عامة يعتبر أكثر تحديداً، فهو عبارة عن استجابة لخطر حقيقي، والجدير بالذكر أنه لا يوجد مثير واحد يُحدث الخوف في مرحلة الطفولة، بل هناك مجموعة من العوامل، ويتعلم الطفل من خلال نموه التمييز بين ما هو مألوف (لذلك فهو في أمان) وما هو غير مألوف (يعتبره خطراً عليه) وقد قام جيرسلو وهولمر (1935) بدراسة واسعة لمخاوف الأطفال في فترة ما قبل المدرسة، حيث سُجّلت مخاوف الأطفال والظروف المتصلة بها لمدة /21/ يوماً، وقد كانت نتيجة الدراسة أن المخاوف من الأشياء الحقيقية (الضوضاء أو الأشياء أو الأشخاص أو الحركات المفاجئة غير الموقعة والغريب من الأشياء والمواقف والأشخاص) كانت تتناقص بتقدّم العمر، على حين أن المخاوف من أخطار متوهمة أو خارقة للطبيعة (كالوقائع المرتبطة بالظلام والأحلام واللصوص والمخلوقات الخرافية وأماكن وقوع الحوادث) فكانت تزاد بتقدم العمر، كما لوحظ أن العلامات المرتبطة بالخوف (مثل البكاء - الهلع - الانسحاب) كانت تتناقص من حيث التكرار أو الشدة كلما تقدّم الطفل بالعمر.
ويصعب التنبؤ بمخاوف الأطفال إلى حدّ كبير بسبب الفروق الفردية الكبيرة من حيث القابلية للخوف ومن حيث مبلغ تعرضهم للخوف، فالمثير الواحد قد يكون مخيفاً إلى حدٍّ كبير بالنسبة لطفل ما، بينما لا يُحدث شيئاً من الاضطراب لطفل آخر، كما أن الطفل نفسه يمكن أن يضطرب كثيراً بمنبه خاص في موقف معين، ثم لا يعيره انتباهاً في موقفٍ آخر[12].
فمثلاً، الطفل الذي يعيش في الريف لا يخشى الحيوانات الأليفة كالكلب أو البقرة أو النعجة، لكن الطفل الذي يتربى في المدن يخافها، وهذه إشارة إلى تأثير البيئة ومخاوف الأطفال تتكون أثناء الطفولة الباكرة ونتيجة لتعاملهم مع البيئة وتأثرهم بالنمط بالحضاري لهذه البيئة وما فيها من مفاهيم وعادات وأساطير ومواقف[13].
5 - أسباب خوف الأطفال :
إن للخوف عند الأطفال مصادر كثيرة من أهمها :
أ - الخبرات غير السارّة : إن الخبرات غير السارة التي يمرّ بها الأطفال تترك آثاراً سلبية لا تزول بسهولة، إذا يخاف الطفل من تكرار الخبرات المؤلمة التي مرّ بها كالعلاج الطبي أو عملية جراحية أو أن يكون قد تعرّض للعض مثلاً أو التهديد من قبل حيوان ما يمكن أن يسبب له خوفاً محدداً من ذاك الحيوان أو خوفاً من جميع الحيوانات أو توجهاً عاماً للخوف من أي موقف، ويمكن أن يتسع مدى الخوف بالنسبة لموضوع الخوف الأصلي بالتعميم حيث يمتد ليشمل لدى الأطفال مجالات متعددة. فالخبرة التي يمر بها طفل صغير مع كلب ما يمكن أتؤدي إلى خوف من جميع الطلاب وجميع الحيوانات وجميع الأشياء ذات الفراء - كذلك من الخبرات غير السارة التي مكن أن يكون قد تعرّض لها - السقوط - الاصطدامات - الرعد - الحرق بشيء ما - المياه مثلاً : يمكن أن يصبح الاستحمام مخيفاً للطفل بسبب الانزلاق في الماء أو لسع الصابون عندما يدخل عينيه.
ب - التأثير على الآخرين : إن الطفل يمكن أن يستخدم المخاوف كوسيلة للتأثير على الآخرين واستغلالهم، فأحياناً قد يكون إظهار الطفل الخوف هو إحدى الطرق القوية لجذب الانتباه، وهذه الطريقة[14] تعزز بشكل مباشر وجود المخاوف لدى الطفل. وهكذا يؤدي الخوف إلى حالة من الارتياح والرضى على نحو يزيد من حالة الشعور بالخوف، والمشكلة أن الخوف يصبح مريحاً ومؤلماً في آن واحد، ويزداد الأمر تعقيداً عندما يكون الخوف هو الطريقة الوحيدة لدى الأطفال للتأثير على والديهم، وكلما أظهر الطفل خوفه فإن الوالدين يسعيان لتهدئة الطفل، رغم ذلك فهم يفشلون في الوصول إلى هذا الهدف، ومن الأمثلة على هذا النمط من السلوك الخوف المرضي من الذهاب إلى الروضة، إذ يُظهر الطفل خوفاً شديداً من الذهاب إليها وتكون النتيجة أن يسمح له الوالدان البقاء في البيت، وبذلك يحصل الطفل على ما يريد من تجنب الروضة والبقاء في البيت، ويقوى هذا الخوف إذا كان الوالدان مترددين حول إرسال الطفل للروضة وعملا دون قصد على جعل إقامته في البيت متعة أو خبرة سارة بالنسبة له، كأن يعطي اهتماماً زائداً لم يكن ليحصل عليه من قبل، ونتيجة لذلك يصبح الخوف وسيلة يستخدمها الطفل للتأثير على الآخرين، وقد يفقد السبب الرئيسي للخوف فاعليته إلا أن الخوف نفسه يبقى ويصبح عادة[15].
ج - الحساسية في الاستجابة ذات المنشأ الولادي : يوصف بعض الأطفال بأنهم كانوا دائماً حساسين للغاية وخوّافين منذ الولادة أو خلال السنة الأولى أو الثانية من العمر، وهؤلاء الأطفال يُظهرون استجابات جدّ قوية للأصوات أو للحركة المفاجئة أو للتغيرات في البيئة...الخ. والاستنتاج الواضح هو أن الأجهزة العصبية المركزية لهؤلاء الأطفال هي منذ الولادة أكثر حساسية من غيرها، ولذلك فهم يستجيبون لمثيرات أضعف ويحتاجون إلى وقت أطول لاستعادة توازنهم، وينتج ذلك عن مزيج من العوامل الوراثية وظروف الحمل والولادة - لذلك فإن هؤلاء الأطفال يستجيبون بهذه الطريقة بحكم تكوينهم، فالطفل الذي يبكي بعنف لصوت مفاجئ متوسط الشدة قد يكون أكثر تهيؤاً لتطوير مخاوف شديدة، والتي يمكن تعميمها بسرعة وسهولة على مواقف أخرى، ثم يعمم هذه المخاوف على مواقف أخرى وهكذا.
وعندما يصل هؤلاء الأطفال إلى عمر /4/ أو /5/ سنوات تكون المخيلة قد منت جيداً فيظهر لديهم ميل قوي لتخيّل جميع أشكال الحوادث المزعجة، وعندما تزداد شدة المخاوف وتطول فترتها بشكل ملحوظ فإنها تصبح مخاوف مرضية يمكن أن تؤثر على حياة الطفل، وفي الغالب تؤثر على حياته اليومية، فمثلاً قد يخاف الطفل الزائد الحساسية من الاستغراق في النوم متخيلاً أنه قد لا يستيقظ من نومه أو أنه سوف يحلم أحلاماً مرعبة[16].
د - الضعف النفسي أو الجسمي : يكون الأطفال أكثر استعداداً لتطوير المخاوف عندما يكونون متعبين أو مرضى، وخصوصاً إذا استمرت حالة الضعف الجسمي لفترة طويلة، فهي ستؤدي إلى شعورٍ بالعجز وضعف المقاومة بحيث تصبح الدفاعات السيكولوجية للطفل أقل فاعلية، وعندما يكون اعتبار الذات لديه منخفضاً يكون أكثر عرضة لتطوير المخاوف، إذ يشعر بالحزن والعزلة والعجز وضعف القدرة على التعامل مع المشاعر والأفكار المثيرة للخوف، والآباء المتساهلون يسهمون أكثر من اللازم في تطوير قبل هذا النمط من السلوك لأنهم لا يساعدون الطفل على تطوير الشعور بالجدارة الناتج عن مراعاة الحدود التي يفرضها الآباء للسلوك أو تلبية المتطلبات - إن الأطفال الضعيفين جسمياً يشعرون بعدم القدرة على التعامل مع الأخطار الواقعية أو المتخيلة.
هـ - الاستجابة للجو العائلي :
¨ النقد والتوبيخ : إن النقد الزائد للأطفال قد يؤدي إلى تطوير شعور بالخوف لديهم، حيث[17] يشعرون بأنهم غير قادرين على فعل شيء صحيح، ويبدو هؤلاء الأطفال كأنهم يتوقعون النقد دائماً، وهذا يؤدي بدوره إلى أن الطفل يفقد الثقة بنفسه ويظهر عليه الجبن والخنوع. كما أن التهديد المتكرر بالتقييم السلبي يؤدي إلى نتيجة مشابهة، فمثلاً عندما يُوبخ الطفل لأنه وسّخ ملابسه فإن النتيجة ستكون ظهور الخوف من الاتساخ لديه، وقد يتعمم هذا الخوف ليصبح خوفاً من الفوضى، ويعتمد شكل الخوف على الجانب الذي يوجه النقد إليه، فالأطفال الذين يُنتقدون بسبب فاعليتهم أو نشاطهم قد يصبحون أطفالاً خجولين خوافين[18].
¨ الضبط والمتطلبات الزائدة : إن الأطفال الذين يعيشون في جو بيت يتسم بالضبط الزائد يمكن أن يصبحوا أطفالاً خوافين بشكل عام أو أطفالاً يخافون من السلطة بشكل خاص، فقد يخافون من المعلمين أو رجال الشرطة أو ممن يمثلون السلطة.
أحياناً يستخدم التخويف من قبل الأهل لحفظ النظام أو لدفع الطفل لعمل معين أو منعه من عمل معين كاللعب أو الضوضاء، وهذا التهديد هو مصدر كامن للمخاوف التي تعيق نمو الطفل. وهناك آباء ذوو متطلبات زائدة لا يحتملون المخاوف المؤقتة التي تظهر لدى أطفالهم ولا يتقبلونها ونتيجة لتوقعهم أن يكون الطفل كما يريدون فهم يوجهون النقد للطفل لأنه يتصرف بشكل طبيعي، وتوقعات الآباء المبالغ فيها هي سبب قوي لخوف الأطفال من الفشل[19].
¨ الصراعات الأسرية : إن الجو المتوتر في البيت الذي تحدث الصراعات المستمرة بين الوالدين أو بين الأخوة أو بين الآباء والأبناء يؤدي إلى شعور بعدم الأمن. والأطفال الذين لا يشعرون بالأمن يحسون بأنهم أقل قدرة من غيرهم على التعامل مع مخاوف الطفل العادية، وحتى المناقشات اليومية حول المشكلات المالية أو الاجتماعية يمكن أن تخيف الأطفال وخاصة الحساسين الذين يشعرون بأنهم مثقلون بمشكلات الأسرة التي لا يستطيعون فهمها ويسيئون تفسيرها باعتبارها مشكلات لا أمل في حلّها. وتتضخم هذه المشاعر إذا أدرك الأطفال وجود ضعف في قدرة الآباء على مواجهة المشكلات[20].
¨ تقليد الخوف : يخاف الطفل عن طريق المشاركة الوجدانية لأفراد أسرته ومن يخالطهم في البيئة، كما يتعلم الخوف بتقليده لسلوكهم من خلال ملاحظته الخوف لدى الكبار أو الأخوة أو الرفاق. ومن المعتاد أن نرى لدى الأطفال شديدي الخوف واحداً من الوالدين على الأقل لديه مخاوف شديدة، فمثلاً الأم التي تخاف من الكلاب أو المرتفعات قد يعاني طفلها من خوف مشابه. وبما أن الخوف يتم تعميمه فإنه من المحتمل أن يطوّر الطفل خوفاً من أي شيء، وهناك بعض الأطفال أكثر عرضة من غيرهم للخوف بسبب وضعهم المزاجي العام. لذا فمن المتوقع أن يعاني أحد أطفال الأبوين الخوافين من حالة خوف شديد بينما لا يعاني أشقاؤه من أية مخاوف. والمخاوف التي تكتسب عن هذا الطريق تمتاز بطول بقائها وتقاوم العلاج والانطفاء بشكل خاص[21].
[1] مشكلات الأطفال اليومية، دوغلاس توم ؛ ترجمة اسحق رمزي، 1953، ص 141.
[2] مشاكل الأطفال كيف نفهمها، محمد أيوب الشحيمي، 1994، ص 98 - 99.
[3] مخاوف الطفل وعدم ثقته بنفسه، ملاك جرجس، 1993، ص 8.
[4] علم النفس التكويني، صباح حنا هرمز، يوسف حنا إبراهيم، 1988، ص 357.
[5] مشاكل الأطفال كيف نفهمها، محمد أيوب الشحيمي، 1994، ص 98 - 99.
[6] مخاوف الطفل وعدم ثقته بنفسه، ملاك جرجس، 1993، ص 8.
[7] مشكلات الأطفال والمراهقين، شارلز شفير، هوارد ميلمان ؛ ت: نسيمة داود، نزيه حمدي، 1989، ص 128.
[8] علاجك النفسي بين يديك، كيلرويكس ؛ ت: عبد العلي الجسماني، 1994، ص 20.
[9] المرجع السابق نفسه، ص 20 - 21.
[10] مخاوف الطفل وعدم ثقته بنفسه، ملاك جرجس، 1993، ص 9.
[11] مشكلات الأطفال والمراهقين، شارلز شفير، هوارد ميلمان ؛ ت: نسيمة داود، نزيه حمدي، 1989، ص 128.
[12] علم النفس التكويني، صباح حنا هرمز، يوسف حنا إبراهيم، 1988، ص 357 - 358 - 359.
[13] مشاكل الأطفال كيف نفهمها، محمد أيوب الشحيمي، 1994، ص 98 - 99.
[14] مشكلات الأطفال والمراهقين، شارلز شفير، هوارد ميلمان ؛ ت: نسيمة داود، نزيه حمدي، 1989،
ص 129 - 131.
[15] المرجع السابق نفسه، ص 131.
[16] المرجع السابق نفسه، ص 132.
[17] المرجع السابق نفسه، ص 131.
[18] المرجع السابق نفسه، ص 132.
[19] المرجع السابق نفسه، ص 132.
[20] مخاوف الطفل وعدم ثقته بنفسه، ملاك جرجس، 1993، ص 15.
[21] المرجع السابق نفسه، ص 15.
يتبع في الاسفل
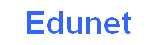



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس


