شرح نص لولا الجمال – محور الفنون – مع الاجابة عن الاسئلة – تاسعة أساسي – للكاتب المصري أحمد أمين
كود:9eme arabe, محور الفنون, محور الفنون 9 اساسي, محور الفنون تاسعة اساسي, آدونات, آدونات كافيه, لغة عربية, لغة عربية 9 اساسي, لغة عربية تاسعة اساسي, الاجابة على اسئلة نص لولا الجمال, لولا الجمال محور الفنون, cha7nas 9eme, char7nas 9eme de base, charh nas, chr7 nas 9eme, تاسعة اساسي, edunet.tn, شرح, شرح نص, شرح نص 9 اساسي, شرح نص لولا الجمال محور الفنون, أحمد أمين, نص لولا الجمال محور الفنون
نص لولا الجمال
عجب صديقي الدكتور إحسان موسى الحسيني إِذْ سَمِعَ مِنِّي لأول مَرَّةٍ إعجابي
بجمال عيون سيدة . كانت تعلمني . ونقدني بعض إخواني في لجنة التأليف . أن
أَذْكُرَ مِثْلَ هذا في بيئة أكثر فيها الخلعاء من ذكر الجمال وصور الجمال حتى
استهتر الشباب وانغمسوا في اللهو وأفرطوا في التهتك . قالوا : « فالواجب يقضي ....
أن لا يأتي ذكر الجمال على لساننا ، فإنّهم إذا اتجهوا إلى الجمال لم يقفوا عند حد ،
وجرفهم التيار حتى يغرقهم . وأرى أن هذا سوء تقدير للجمال وظلم له ، وكأن
الفضيلة أن يكون الإنسان حجرًا لا يأنس بجمال ولا يَنْفُرُ مِنْ قَبْح ... )
وفي رأيي أن شرور العالم كلها تنشأ من سوء تقدير الجمال لا من حسن تقديره ،
والذين يستهترون ويفرطون في اللهو إنما أتاهُم ذلك من قصر نظر إلى الجمال ، لا
من سعة نظر فيه ، ومن انحطاط في فهمه لا من سمو في إدراكه ، ومن الخطا أن نعد
الجمال من كماليات الحياة ، فإنه من ضرورياتها ، وأن نعده مُنْعَةً مِنْ منع ساعات
الكسل والفراغ ، فإنه لابد أن يملأ حياتنا ، ومن قصر النظر أن نقصره على أنواع من
الزينة وعلى ضروب من الأشكال وعلى أنماط من المظاهر ، فهو أعمق من أن يكتفي
فيه بالسطح .
ما الدنيا إذا فقدت الجمال ، وفقدنا شعورنا بالجمال ؟ إنها - إذن - لا تستحق الحياة
فيها ساعة ، فما يقومها ويجعلها تستحق البقاء إلا أَنْ كُلَّ شَيْءٍ فِيها مَرْجَ قَصْدُ
النفع مِنْه بقصد التجميل [ يقول تعالى ] : « ولكم فيها جمال حين تريحون وحين
تسرحون ( 6 ) وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إِلا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ، إِن رَبَّكُمْ
الرؤوف رحيم ( 7 ) والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينةً ، ويَخْلُقُ مالا
تَعْلَمُونَ ( 8 ) .. [ سورة النحل الآيات 6-7-8 ]
فلولا الجمال والشعور به لبقيت الكهوف والمغارات مساكن الإنسان الآن كما كانت
مساكن الإنسان الأول ولولا الجمال ما كانت الحدائق والبساتين ( ... ) ولولا الجمال
لاخْتَفَى كُلُّ فَنْ ، فلا أدب ولا تصوير ولا نقش ولا موسيقى .... بل وما كان الإنسان
إلا الة حقيرة ، يعمل وينتج ويستهلك ...
إن تقدم الإنسانية في المدنيّة والحضارة ، والدين والعلم ، والاختراع والخلق ، يدين
للشعور بالجمال أكثر من أي شيء آخر ... لقد تنبه شعور الإنسان بالجمال رويدا
رويدا فرأى وجه الظلم قبيحا ، فنفر منه ، ووجه الرّق ذميمًا ، فَاشْمَأَرْ مِنه ، بقَدْرِ ما
اسْتَجمَل العدل والحرية والإخاء والمساواة فهانت عليه التضحية في سبيل
جمالها ... والفرق بين أمة راقية وأمة منحطة ، هو الشعور بالجمال ، فهو ينظفها ،
وهو يمدنها ، وهو ينظم مدنها ، وهو يُرقّي عقلها ، وهو الذي يحقق العدل فيها ، وهو
الذي يحسن العلاقة بين أفرادها وبين أفرادها وحكوماتها ، فَامْنَحْنِي الشُّعُور
بالجمال تمنحني كُلَّ شَيْءٍ ، وَاحْرِ مُنِيهِ أَحرَمُ كُلَّ شَيْءٍ .
أفبعد هذا لله - يا أخي - تنكر علي شعوري بالجمال ، وتنصحني بستره ؟
أحمد أمين / فيض الخاطر / الجزء 5
مكتبة النهضة المصرية - ط - القاهرة : 1983 ص 114- 119
شرح نص لولا الجمال
تقديم النص:
نص حجاجي بعنوان لولا الجمال يندرج ضمن محور الفنون للكاتب والاديب المصري أحمد امين، من مؤلفاته: كتاب إلى
ولدي و قيض الخاطر في عشرة أجزاء ومنها اقتطف هدا النص تحديدا من الجزء الخامس
يتناول فكرة تأثير الجمال في الحياة والفنون والمجتمع، ويعتبر أن الجمال عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه. يبدأ الكاتب أحمد أمين بالإشارة إلى تجربته الشخصية مع الجمال، وينتقل إلى الدفاع عن ضرورة تقدير الجمال والشعور به في مواجهة النقد الذي يوجه له. يدعم حججه باستشهادات من القرآن الكريم، ويبرز كيف أن الجمال يلعب دورًا مهمًا في التمدن والتحضر وتطوير الفنون والثقافة. كما يشير إلى أن الشعور بالجمال يرفع من مستوى الأخلاق والقيم الإنسانية ويسهم في تحسين العلاقات الاجتماعية والنفسية.
النص يعكس رؤية الكاتب لأهمية الجمال في الحياة البشرية، وكيف يمكن لتقديره أن يسهم في بناء مجتمع أكثر تطورًا وإنسانية.
موضوع النص:
يؤكد الكاتب على أهمية الجمال في حياة الانسان ودوره في الرقي به
النص يتناول موضوع تقدير الجمال وأهميته في حياة الإنسان. يبرز الكاتب أحمد أمين كيف أن الجمال هو عنصر أساسي في تطوير الحضارة والتمدن، وكيف يسهم تقدير الجمال في نشأة الفنون الجميلة وتحسين القيم الإنسانية والعلاقات الاجتماعية. يعبر النص عن فكرة أن الجمال ليس مجرد كماليات في الحياة، بل هو ضرورة يجب أن نعتني بها ونقدّرها لتحقيق مجتمع راقٍ ومزدهر.
تقسيم النص:
المعيار : حسب سيرورة الحجاج
1- من البداية الى قبح : الأطروحة المدحوضة
2- من وفي رأسي إلى كل شيء : سيرورة الحجاج
3- البقية : الأطروحة المدعومة
استعد
1. اشرح الكلمات الآتية حسب السياق الذي وردت فيه في النص استهتر انغمسوا جرفهم ذميما
شرح الكلمات حسب السياق الذي وردت فيه في النص:
- استهتر: يعني التهاون والاستهانة بالقيم والأخلاق. في النص، يُستخدم لوصف الشباب الذين لا يعيرون اهتمامًا للجمال وصوره، مما يؤدي إلى انغماسهم في اللهو والتهتك.
- انغمسوا: يعني التورط العميق في شيء معين. في النص، يُستخدم لوصف الشباب الذين غرقوا في اللهو والتهتك نتيجةً لسوء تقديرهم للجمال.
- جرفهم: يعني سحبهم بقوة وغالبًا ما يُستخدم مع الماء أو التيار. في النص، يُستخدم لوصف الشباب الذين انجرفوا مع تيار اللهو والتهتك حتى غرقوا فيه.
- ذميما: يعني قبيحًا أو سيئًا. في النص، يُستخدم لوصف وجه الرق، حيث يُعبر الكاتب عن اشمئزازه من الرق بسبب قبحه.
2. قطع النص وفق معيار البنية الحجاجية الثلاثية .
البنية الحجاجية الثلاثية تتكون من:
- المقدمة: عرض القضية أو المشكلة.
- العرض: تقديم الحجج والأدلة لدعم القضية.
- الخاتمة: تلخيص النقاط الرئيسية وإعطاء استنتاجات أو توصيات.
تطبيق هذه البنية على النص.
المقدمة: الكاتب يتحدث عن موضوع الجمال وكيف أنه يعجب بجمال عيون سيدة كانت تعلّمه، ويوضح كيف أن البعض ينتقد ذكر الجمال في بيئة يتصف شبابها بالاستهتار والانغماس في اللهو.
العرض: الكاتب يدافع عن أهمية الجمال ويرى أن سوء تقدير الجمال هو سبب الشرور، وليس حسن تقديره. ويؤكد على أن الجمال هو من ضروريات الحياة وليس من الكماليات. ويشير إلى أن الجمال لا يقتصر على الزينة والأشكال السطحية بل هو أعمق من ذلك. ويعزز حجته بآيات من القرآن الكريم.
كما يشدد على أن الجمال قد أسهم في تطور الإنسانية، ودفعها لمحاربة الظلم والرق والسعي نحو العدل والحرية والمساواة. ويرى أن الشعور بالجمال هو الذي يميز بين الأمة الراقية والأمة المنحطة.
الخاتمة: الكاتب يخلص إلى أن الشعور بالجمال هو ما يجعل الحياة تستحق العيش، وهو الذي يمدن الأمم ويرتقي بعقولها ويحقق العدل فيها. وبالتالي، ينصح بعدم كتمان الجمال بل التعبير عنه والشعور به.
3. ما الوضعية الحجاجية القادحة للحجاج في النص ؟
الوضعية الحجاجية القادحة في النص تتمثل في النقد الذي وُجه للكاتب من قِبَل إخوانه في لجنة التأليف وأصدقائه. حيث أنهم يرون أن ذكر الجمال وإظهاره في بيئة ينتشر فيها اللهو والاستهتار قد يؤدي إلى تفاقم التهتك والانغماس في اللهو، مما يجرف الشباب بعيدًا عن الفضيلة.
هذا النقد هو الشرارة التي دفعت الكاتب إلى الدفاع عن أهمية الجمال في حياة الإنسان، وتقديم الحجج والأدلة التي تبيّن أن التقدير الصحيح للجمال يساعد في النهوض بالإنسانية وتحقيق العدل والحرية والمساواة، ويحفز التقدم في مختلف مجالات الحياة.
4. حدد أطراف الحجاج في النص .
أطراف الحجاج في النص تتضمن:
- الكاتب (أحمد أمين): يعبر عن إعجابه بالجمال ويؤكد على أهميته في حياة الإنسان. يدافع عن تقدير الجمال ويرى أنه عنصر أساسي للنهوض بالإنسانية وتطورها.
- النقاد (أصدقاؤه وإخوانه في لجنة التأليف): ينتقدون ذكر الجمال ويرون أنه قد يؤدي إلى زيادة التهتك والاستهتار بين الشباب، ويدعون إلى كتمانه وعدم الحديث عنه.
كل طرف يقدم حججه ودلائله للدفاع عن موقفه، مما يشكل الوضعية الحجاجية في النص. أحمد أمين يستعمل الأدلة القرآنية والتجارب الإنسانية لإبراز أهمية الجمال، بينما النقاد يحذرون من تأثيره السلبي على الأخلاق والسلوك الاجتماعي.
5 في النص أطروحتان مدحوضة ومثبتة بينهما وأسند كل واحدة بطرف الحجاج المناسب له
ما أهمية تكرار المؤشر اللغوي " لولا " في النص ؟
الأطروحة المدحوضة: يتمثل هذا الطرح في النقد الموجه للكاتب من قبل إخوانه في لجنة التأليف وأصدقائه، حيث يرون أن ذكر الجمال في بيئة مغمورة بالانغماس واللهو قد يؤدي إلى تفاقم التهتك والاستهتار بين الشباب. نقدهم يعبر عن خوفهم من تأثير الجمال السلبي على أخلاق وسلوك الشباب.
الأطروحة المثبتة: تتجلى في دفاع الكاتب عن الجمال وأهميته في حياة الإنسان. يعتقد الكاتب أحمد أمين أن سوء تقدير الجمال هو ما يؤدي إلى الشرور، وليس حسن تقديره. ويرى أن الجمال ضروري لتقدم الإنسانية وتحقيق العدالة والحرية والمساواة، وأنه لا ينبغي أن يُقتصر على السطحية بل يجب أن يشمل عمق الحياة.
أطراف الحجاج المناسبة:
- الكاتب (أحمد أمين) يمثل الأطروحة المثبتة.
- النقاد (أصدقاؤه وإخوانه في لجنة التأليف) يمثلون الأطروحة المدحوضة.
أهمية تكرار المؤشر اللغوي "لولا" في النص: تكرار كلمة "لولا" في النص يُستخدم كأداة بلاغية وحجاجية قوية، حيث يشير إلى أهمية الجمال في حياة الإنسان وفي تقدم الحضارة. كل مرة يُكرر فيها الكاتب "لولا" يعزز حجته بأن الجمال هو العامل الأساسي والمحفز في العديد من جوانب الحياة، سواء كانت سكن الإنسان، الحدائق، الفنون أو تطور الإنسانية. هذا التكرار يعمل على تأكيد الفكرة وترك أثر أقوى على القارئ حول الدور الحيوي للجمال.
أبني المعنى :
1. ما أهمية الشاهد القرآني في ضوء معرفتنا ببيئة الكاتب ويزمن ولادة النص ؟
الشاهد القرآني يُستخدم في النص لتعزيز حجج الكاتب وإضفاء مصداقية دينية وثقافية على آرائه، وهذا أمر ذو أهمية خاصة في ضوء بيئة الكاتب وزمن ولادة النص.
1. البيئة الثقافية والدينية: الكاتب أحمد أمين عاش في مصر خلال فترة شهدت تداخل بين التأثيرات الثقافية الغربية والقيم الإسلامية التقليدية. النص يعكس هذا التوازن، حيث يواجه الكاتب النقد الديني والأخلاقي المتحفظ على ذكر الجمال. باستخدام الشواهد القرآنية، يقدم الكاتب دليلاً من داخل النصوص الدينية التي تكون موثوقة ومقبولة لدى الجمهور المستهدف.
2. تعزيز المصداقية: الشواهد القرآنية تُستخدم لإضفاء مصداقية إضافية على حجج الكاتب. القرآن الكريم يُعد مصدرًا موثوقًا لدى المسلمين، واستخدامه يعزز حجج الكاتب ويجعلها أكثر قبولاً لدى جمهوره.
3. التأكيد على أهمية الجمال: الآيات القرآنية التي أوردها الكاتب تُظهر أن الجمال جزء من التصميم الإلهي للعالم وأنه ليس مجرد زينة أو كماليات، بل هو عنصر أساسي له دوره في حياة الإنسان. هذا يساعد الكاتب في دحض الانتقادات وتأكيد أن التقدير الصحيح للجمال هو جزء من القيم الدينية وليس ضدها.
باختصار، الشاهد القرآني في النص يعزز حجج الكاتب ويجعلها أكثر قبولاً ومصداقية لدى جمهوره، ويساعد في التأكيد على أهمية الجمال في حياة الإنسان من منظور ديني وثقافي.
2 استخرج من النص ما يؤكد تحمس الكاتب الشديد لموقفه من الجمال .
النص يحتوي على عدة مقاطع تعبر عن تحمس الكاتب الشديد لموقفه من الجمال. إليك بعض الأمثلة:
- "وفي رأيي أن شرور العالم كلها تنشأ من سوء تقدير الجمال لا من حسن تقديره": هنا يعبر الكاتب عن اعتقاده بأن تقدير الجمال بشكل صحيح يمكن أن يحل الكثير من مشاكل العالم.
- "فما الدنيا إذا فقدت الجمال ، وفقدنا شعورنا بالجمال ؟ إنها - إذن - لا تستحق الحياة فيها ساعة": هذا يعبر عن مدى أهمية الجمال في حياة الإنسان من وجهة نظر الكاتب، حيث يعتقد أن فقدان الجمال يجعل الحياة غير مستحقة للعيش.
- "إن تقدم الإنسانية في المدنيّة والحضارة ، والدين والعلم ، والاختراع والخلق ، يدين للشعور بالجمال أكثر من أي شيء آخر": هنا يشدد الكاتب على أن كل تقدم الإنسانية في مختلف المجالات يعود الفضل فيه إلى الشعور بالجمال.
- "أفبعد هذا لله - يا أخي - تنكر علي شعوري بالجمال ، وتنصحني بستره ؟": في هذا المقطع يعبر الكاتب عن استغرابه من رفض الآخرين لشعوره بالجمال ويظهر تمسكه بموقفه.
هذه المقاطع تظهر بوضوح حماس الكاتب الشديد لموقفه من الجمال وأهمية تقديره في الحياة.
3 ربط الكاتب بقوة بين تقدير الجمال وجميع منجزات البشرية المادية والروحية . وضح ذلك .
صحيح، الكاتب أحمد أمين يربط بقوة بين تقدير الجمال وجميع منجزات البشرية المادية والروحية في النص، ويمكن توضيح ذلك من خلال النقاط التالية:
- التقدم المادي:
- يشير الكاتب إلى أن الشعور بالجمال هو ما دفع الإنسان لتحسين بيئته والسعي نحو التمدن والتحضر. على سبيل المثال، يقول: "فلولا الجمال والشعور به لبقيت الكهوف والمغارات مساكن الإنسان الآن كما كانت مساكن الإنسان الأول". هذا يعني أن الجمال هو الذي دفع الإنسان لابتكار المنازل الحديثة وتحسين المساكن.
- يضيف الكاتب أن الجمال هو الذي جعل الإنسان يزرع الحدائق والبساتين، ويبتكر الفنون المختلفة مثل الأدب والتصوير والنقش والموسيقى. هذه الأنشطة تعكس التقدم المادي للحضارة.
- التقدم الروحي:
- يرى الكاتب أن تقدير الجمال هو ما دفع الإنسان لمحاربة الظلم والرق، ويسهم في تحقيق العدل والحرية والمساواة. يقول: "لقد تنبه شعور الإنسان بالجمال رويدا رويدا فرأى وجه الظلم قبيحا، فنفر منه، ووجه الرّق ذميمًا، فاشمأر منه". هذا يعني أن تقدير الجمال ساهم في رفع القيم الإنسانية والنضال من أجل حقوق الإنسان.
- يعتقد الكاتب أن الشعور بالجمال يؤدي إلى تحسين العلاقة بين أفراد المجتمع وبين الأفراد وحكوماتهم. هذا يسهم في التقدم الروحي للمجتمع ويحقق العدالة والسلام الاجتماعي.
في النهاية، يجمل الكاتب فكرته بأن تقدير الجمال هو الذي يدفع الإنسانية نحو التقدم في جميع المجالات، سواء كانت مادية أو روحية، ويؤكد أن الجمال ضرورة لا غنى عنها لحياة الإنسان ولتحقيق الرقي الحضاري.
4 وضح العلاقة بين تقدير الجمال ونشأة الفنون الجميلة انطلاقا من قول الكاتب الآتي : « ولولا الجمال
لاختفى كلُّ فَن ، فلا أدب ولا تصوير ولا نقش ولا موسيقى
يتناول الكاتب أحمد أمين في قوله "ولولا الجمال لاختفى كل فَن ، فلا أدب ولا تصوير ولا نقش ولا موسيقى" العلاقة الوثيقة بين تقدير الجمال ونشأة الفنون الجميلة. من هذا القول، يمكننا فهم أن الجمال هو القوة الدافعة والملهمة التي تقف وراء جميع أشكال الفنون.
الفنون الجميلة مثل الأدب، التصوير، النقش، والموسيقى، تنبع من رغبة الإنسان في التعبير عن الجمال الذي يراه في العالم من حوله. عندما يقدر الإنسان الجمال ويشعر به، يدفعه هذا التقدير إلى إنشاء أعمال فنية تعكس هذا الجمال وتزيد من قيمته. بدون هذا الشعور بالجمال، لن يكون هناك دافع لدى الإنسان لإبداع الفنون، وستفقد هذه الفنون وجودها وأهميتها.
تقدير الجمال هو ما يجعل الإنسان يلتقط لحظة جميلة في صورة، أو يرسم منظرًا طبيعيًا خلابًا، أو يعبر عن مشاعره وأفكاره في قصة أو قصيدة، أو يخلق نغمات موسيقية تعبر عن جمال الحياة. بعبارة أخرى، الجمال هو الوقود الذي يغذي الفنون ويمدها بالحياة والروح.
أبدي رأيي :
.1 قيم خطة الكاتب في الحجاج .
خطة الكاتب في الحجاج يمكن تقييمها بناءً على عدة عناصر:
- الوضوح والإقناع:
- الكاتب يستخدم لغة واضحة وسهلة الفهم، مما يسهل على القارئ متابعة حججه.
- يعرض الكاتب قضيته بشكل منظم ومقنع، حيث يستشهد بأمثلة ملموسة من القرآن الكريم لتدعيم حججه.
- التسلسل المنطقي:
- الحجة تتطور بشكل منطقي ومنسق، بدءًا من القاعدة الأساسية التي تقر بأن الجمال عنصر أساسي في الحياة، وصولاً إلى تأثيره على الحضارة والفنون.
- التدرج في الأفكار يسهم في بناء حجة قوية ومتماسكة.
- استخدام الأدلة والشواهد:
- الكاتب يستعين بنصوص دينية (من القرآن الكريم) وشواهد تاريخية لتدعيم وجهة نظره.
- يقدم أمثلة ملموسة من الحياة اليومية ومن الفنون المختلفة لتوضيح النقطة.
- الرد على النقد:
- يتناول الكاتب النقد الموجه إليه ويرد عليه بشكل مقنع ومنطقي.
- يدافع عن تقدير الجمال بشدة ويظهر كيف أن عدم تقديره يمكن أن يؤدي إلى تدهور الحضارة والفنون.
- العاطفة والاهتمام:
- الكاتب يظهر عاطفة قوية تجاه قضيته، مما يزيد من تأثير حجته على القارئ.
- يجعل الموضوع أكثر قرباً وفهماً للقارئ العادي من خلال استخدام أمثلة واقعية وحقيقية.
بشكل عام، خطة الكاتب في الحجاج تعتبر قوية وفعالة بسبب وضوحها، تسلسلها المنطقي، استخدامها للأدلة والشواهد، الرد على النقد، وإظهار العاطفة.
2 ربط الكاتب كل مظاهر التمدن والتحضر بتقدير الجمال . فهل تشاطره الرأي ؟ علل إجابتك .
أشاطر الكاتب الرأي إلى حد كبير، حيث أرى أن تقدير الجمال يلعب دورًا كبيرًا في تطور المجتمع وتحضره. إليك بعض الأسباب التي تدعم هذا الرأي:
- الفنون والثقافة:
- تقدير الجمال يحفز على إنشاء الأعمال الفنية والأدبية التي تعكس وتزيد من الوعي الثقافي في المجتمع.
- الفنون الجميلة تلهم الناس وتحفز الإبداع والابتكار، مما يسهم في تطوير الحضارة بشكل عام.
- البيئة العمرانية:
- تقدير الجمال يؤدي إلى تصميم المدن والمباني بطرق جذابة ومنظمة، مما يعزز من جودة الحياة ويرفع من مستوى الرفاهية.
- المدن الجميلة تجذب السياحة والاستثمارات، مما يسهم في النمو الاقتصادي.
- القيم الاجتماعية:
- الشعور بالجمال يرفع من مستوى الأخلاق والقيم الإنسانية، حيث يرتبط بتقدير العدالة والحرية والمساواة.
- يعزز من العلاقات الإيجابية بين الأفراد وبين الأفراد والحكومات، مما يسهم في الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
- الصحة النفسية:
- التفاعل مع الأشياء الجميلة والطبيعة يعزز من الصحة النفسية ويقلل من التوتر والقلق.
- الأماكن الجمالية تمنح الناس شعورًا بالراحة والسعادة، مما ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية.
ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هناك عوامل أخرى أيضًا تلعب دورًا كبيرًا في تحضر المجتمعات، مثل التعليم، التكنولوجيا، والاقتصاد. لذا، يمكن القول إن تقدير الجمال هو جزء مهم من هذه الصورة الكاملة.
أستثمر وأوظف :
1. في الصف : اعرض على زملائك في مبادرة منك شيئا جميلا يرونه أو يسمعونه مبرزا مواطن الجمال
فيه حسب رأيك . أو صف في فقرة موجزة جمال مدينتك - حيك - مدرستك ...
سأصف جمال مدينة تونس، عاصمة بلادي:
تونس، تلك المدينة التي تحتضن بين طياتها معاني الأصالة والحداثة، هي مدينة تتباهى بمزيج متناغم من التراث والحداثة. تتميز بساحاتها القديمة المرصوفة بالحجر والتي تضفي طابعًا ساحرًا على مشهدها الحضري. في الأسواق التقليدية، يمكن للزائر أن يشتم عبق التوابل والعطور الممزوجة مع الألوان الزاهية للأقمشة والمشغولات اليدوية. ساحة القصبة وما يحيط بها من مبانٍ تاريخية تروي قصة الحضارة العريقة التي شهدتها المدينة.
أما في الجانب الحديث من تونس، فتنبض المدينة بالحياة عبر شوارعها الواسعة والمباني العالية التي تعكس التطور والرقي. الحدائق العامة مثل حديقة البلفدير تقدم للناس مساحات خضراء للاستمتاع بالطبيعة والتنزه. وعلى شاطئ المتوسط، يمكن أن تشهد عيونك الشروق والغروب في لوحة فنية ربانية تستحق التأمل.
مدينة تونس تجمع بين الجمال الطبيعي والتراث الثقافي في تناغم يعكس روح أهلها وحبهم للحياة. إنها مدينة تستحق الزيارة والاستكشاف، حيث يجد كل زائر ما يرضي ذوقه ويشبع شغفه.
2 خارج الصف اجمع أبياتا شعرية وأقوالا مأثورة تتغنى بالجمال وتمجده واكتبها بخط جميل بيدك
أو بالحاسوب .
بعض الأبيات الشعرية والأقوال المأثورة التي تتغنى بالجمال وتمجده:
أبيات شعرية:
- يقول الشاعر أبو الطيب المتنبي:
- وإذا نظرتَ إلى جمالِ وجوهِهمْ ** ألهتْكَ عن عقلٍ وعن إدراكِ
- يقول الشاعر إيليا أبو ماضي:
- كن جميلاً ترى الوجود جميلاً
- من شعر ابن زيدون:
- يا ليْتَ ما بيني وبَيْنَكِ عامرٌ ** وبيني وبينَ العَوالِمِ خَرابُ
أقوال مأثورة:
- يقول أفلاطون: "الجمال هو رمز الحقيقة."
- يقول جون كيتس: "الجمال هو الحقيقة، والحقيقة هي الجمال؛ هذا كل ما تعرفه على الأرض، وكل ما تحتاج إلى معرفته."
- مقولة شهيرة للكاتبة اللبنانية مي زيادة: "الجمال جمال النفس أولاً وجمال الجسم ثانياً."
من هو أحمد أمين؟
أحمد أمين (1 أكتوبر 1886 - 30 مايو 1954)، أديب ومفكر ومؤرخ وكاتب مصري، وهو صاحب تيار فكري مستقل قائم على الوسطية، عرف بموسوعته: فجر وضحى وظهر ويوم الإسلام، وهو والد المفكرين المعاصرين حسين وجلال أمين.
نشأته وتعليمه
ولد أحمد أمين إبراهيم الطباخ في حي المنشية بالقاهرة في 1 أكتوبر 1886. تدرج في تعليمه من «الكُتّاب» إلى «مدرسة والدة عباس باشا الأول الابتدائية»، إلى «الأزهر»، إلى «مدرسة القضاء الشرعي» حيث نال منها شهادة القضاء سنة 1911م. درّس بعدها سنتين في مدرسة القضاء الشرعي. ثم انتقل في 1913م إلى القضاء فعمل قاضيًا مدة 3 أشهر عاد بعدها مدرسًا بمدرسة القضاء. في 1926م عرض عليه صديقه طه حسين أن يعمل مدرسًا بكلية الآداب بجامعة القاهرة، فعمل فيها مدرسًا ثم أستاذًا مساعدًا إلى أن أصبح عميدًا لها في 1939م.
أنشأ مع بعض زملائه سنة 1914م «لجنة التأليف والترجمة والنشر» وبقي رئيسًا لها حتى وفاته 1954م. شارك في إخراج «مجلة الرسالة» (1936م). كذلك أنشأ مجلة "الثقافة" الأدبية الأسبوعية (1939م). وفي 1946م بعد توليه الإدارة الثقافية بوزارة المعارف، أنشأ ما عرف باسم «الجامعة الشعبية» وكان هدفه منها نشر الثقافة بين الشعب عن طريق المحاضرات والندوات. في نفس الفترة، أنشأ «معهد المخطوطات العربية» التابع لجامعة الدول العربية.، ثم مُنح درجة الدكتوراه عام 1948. وكان عضواً في المجامع اللغوية بدمشق والقاهرة وبغداد.
حياته
مدرسة القضاء الشرعي
أحمد أمين في مدرسة القضاء الشرعي سنة 1916م
نشأت في تلك الفترة مدرسة القضاء الشرعي التي اختير طلابها من نابغي أبناء الأزهر بعد امتحان عسير، فطمحت نفس أحمد إلى الالتحاق بها واستطاع بعد جهد أن يجتاز اختباراتها ويلتحق بها في (1325 هـ / 1907م)، وكانت المدرسة ذات ثقافة متعددة دينية ولغوية وقانونية عصرية وأدبية واختير لها ناظر كفء هو «عاطف باشا بركات» الذي صاحبه أحمد أمين ثمانية عشر عامًا، وتخرج من المدرسة سنة (1330 هـ/1911م) حاصلًا على الشهادة العالمية، واختاره عاطف بركات معيدًا في المدرسة فتفتحت نفس الشاب على معارف جديدة وصمم على تعلم اللغة الإنجليزية فتعلمها بعد عناء طويل، وفي ذلك يقول: «سلكت كل وسيلة لتحقيق هذه الغاية».
شاء الله أن يحاط وهو الشرعي بمجموعة من الطلاب والأساتذة والزملاء لكل منهم ثقافته المتميزة واتجاهه الفكري، فكان يجلس مع بعضهم في المقاهي التي كانت بمثابة نوادٍ وصالونات أدبية في ذلك الوقت يتناقشون، واعتبرها أحمد أمين مدرسة يكون فيها الطالب أستاذًا والأستاذ طالبًا، مدرسة تفتحت فيها النفوس للاستفادة من تنوع المواهب.
كان تأثير عاطف بركات فيه كبيرًا، إذ تعلم منه العدل والحزم والثبات على الموقف، كان يعلمه في كل شيء في الدين والقضاء وفي تجارب الناس والسياسة، حتى إنه أُقصي عن مدرسة القضاء الشرعي بسبب وفائه لأستاذه بعدما قضى بها 15 عامًا نال فيها أكثر ثقافته وتجاربه، لذلك قال عن تركها: «بكيت عليها كما أبكي على فقد أب أو أم أو أخ شقيق».
القضاء
شغل أحمد أمين وظيفة القاضي مرتين الأولى سنة 1332 هـ /1913م في الواحات الخارجة لمدة ثلاثة أشهر، أما المرة الثانية فحين تم إقصاؤه من «مدرسة القضاء الشرعي» لعدم اتفاقه مع إدارتها بعد أن تركها أستاذه عاطف بركات، وأمضى في القضاء في تلك الفترة أربع سنوات عُرف عنه فيها التزامه بالعدل وحبه له، واستفاد من عمله بالقضاء أنه كان لا يقطع برأي إلا بعد دراسة وتمحيص شديد واستعراض للآراء والحجج المختلفة، ولم تترك نزعة القضاء نفسه طيلة حياته بدءًا من نفسه حتى الجامعة.
الجامعة
بدأ اتصال أحمد أمين بجامعة القاهرة سنة (1345 هـ= 1926م) عندما رشحه الدكتور طه حسين للتدريس بها في كلية الآداب، ويمكن القول إن حياته العلمية بالمعنى الصحيح آتت ثمارها وهو في الجامعة فكانت خطواته الأولى في البحث على المنهج الحديث في موضوع المعاجم اللغوية، وكانت تمهيدًا لمشروعه البحثي عن الحياة العقلية في الإسلام التي أخرجت «فجر الإسلام» و«ضحى الإسلام».
تولى في الجامعة تدريس مادة «النقد الأدبي»، فكانت محاضراته أولى دروس باللغة العربية لهذه المادة بكلية الآداب، ورُقِّي إلى درجة أستاذ مساعد، ثم إلى أستاذ فعميد لكلية الآداب سنة (1358 هـ= 1939م)، واستمر في العمادة سنتين استقال بعدهما لقيام الدكتور محمد حسين هيكل وزير المعارف بنقل عدد من مدرسي كلية الآداب إلى الإسكندرية من غير أن يكون لأحمد أمين علم بشيء من ذلك، فقدم استقالته وعاد إلى عمله كأستاذ، وهو يردد مقولته المشهورة: «أنا أصغر من أستاذ وأكبر من عميد».
في الجامعة تصدَّع ما بينه وبين طه حسين من وشائج المودة إذ كان لطه تزكيات خاصة لا يراها أحمد أمين صائبة التقدير، وتكرر الخلاف أكثر من مرة فاتسعت شُقَّة النفور، وقال عنه طه: «كان يريد أن يغيّر الدنيا من حوله، وليس تغير الدنيا ميسرًا للجميع». وقد عد فترة العمادة فترة إجداب فكري وقحط تأليفي لأنها صرفته عن بحوثه في الحياة العقلية.
الجامعة الشعبية
في سنة (1365 هـ= 1945م) ندب للعمل مديرًا للإدارة الثقافية بوزارة المعارف، وهي إدارة تعمل دون خطة مرسومة واضحة فليس لها أول يُعرف ولا آخر يُوصف تساعد الجاد على العمل والكسول على الكسل، وفي توليه لهذه الإدارة جاءت فكرة «الجامعة الشعبية» حيث رأى أن للشعب حقًّا في التعلّم والارتواء العلمي، وكان يعتز بهذه الجامعة اعتزازًا كبيرًا ويطلق عليها اسم «ابنتي العزيزة»، وهي التي تطورت فيما بعد إلى ما سُمي بقصور الثقافة، وكان آخر المناصب التي شغلها بعد إحالته إلى التقاعد منصب مدير الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية.
لجنة التأليف والترجمة والنشر
أشرف أحمد أمين على لجنة التأليف والترجمة والنشر مدة أربعين سنة منذ إنشائها حتى وفاته (1954م)، وكان لهذه اللجنة أثر بالغ في الثقافة العربية إذ قدمت للقارئ العربي ذخائر الفكر الأوروبي في كل فرع من فروع المعرفة تقديمًا أمينًا يبتعد عن الاتجار، كما قدمت ذخائر التراث العربي مشروحة مضبوطة فقدمت أكثر من 200 كتاب مطبوع.
كانت الثقة في مطبوعات اللجنة كبيرة جدًّا لذلك رُزقت مؤلفات اللجنة حظًّا كبيرًا من الذيوع وتخطفتها الأيدي والعقول، كما أنشأت هذه اللجنة مجلة «الثقافة» في (ذي الحجة 1357 هـ / يناير 1939م) ورأس تحريرها، واستمرت في الصدور أربعة عشر عامًا متوالية، وكان يكتب فيها مقالًا أسبوعيًّا في مختلف مناحي الحياة الأدبية والاجتماعية، وقد جمعت هذه المقالات في كتابه الرائع «فيض الخاطر» بأجزائه العشرة. امتازت مجلة «الثقافة» بعرضها للتيارات والمذاهب السياسية الحديثة، وتشجيعها للتيار الاجتماعي في الأدب وفن الرواية والمسرحية، وعُنيت المجلة بالتأصيل والتنظير.
كما كان يكتب في «مجلة الرسالة» الشهيرة وأثرى صفحاتها بمقالاته وكتاباته، وخاض بعض المحاورات مع كبار كتّاب ومفكري عصره على صفحات «الثقافة» ومنها محاورته مع الدكتور زكي نجيب محمود الذي كتب مقالًا نعى وانتقد فيه محققي التراث العربي ونشر ذخائره، ورأى أن الفكر الأوروبي أجدر بالشيوع والذيوع والترجمة من مؤلفات مضى زمانها، وأطلق على كتب التراث «الكتاب القديم المبعوث من قبره»، ثم قال: «سيمضي الغرب في طريقه، وهو يحاول الصعود إلى ذرى السماء، ونحن نحفر الأجداث لنستخرج الرمم». أثارت هذه الكلمات المجحفة للتراث أحمد أمين فردّ على ما قيل وأكد أن الغرب أسس نهضته ومدنيته على الحضارة الرومانية واليونانية، وأكد أيضًا أن المستشرقين هم أول من اهتم بالتراث العربي فنشروا أصوله وذخائره.
السياسة
كانت السياسة عند أحمد أمين تعني الوطنية لا يرى فرقًا بينهما، وترجع معرفته بالسياسة وأقطابها إلى أستاذه عاطف بركات، وقد أُعجب الزعيم سعد زغلول به وبوطنيته، وبدقة تقاريره التي كان يكتبها عن أحوال مصر إبان ثورة 1919 ورغم ميله للوفد فإنه لم يشارك في السياسة بقدر كبير خوفًا من العقوبة، وفي صراحة شديدة يقول: «ظللت أساهم في السياسة وأشارك بعض من صاروا زعماء سياسيين ولكن لم أندفع اندفاعهم ولم أظهر في السياسة ظهورهم لأسباب أهمها لم أتشجع شجاعتهم، فكنت أخاف السجن وأخاف العقوبة».
لما قارب سن التقاعد اعتذر عن رئاسة تحرير جريدة الأساس التي اعتزم السعديون إصدارها، وكان في ذلك الوقت منصرفًا لأعماله الثقافية والفكرية المختلفة، لذلك كان بعده عن السياسة موافقًا لهوى في نفسه من إيثار العزلة واستقلال في الرأي وحرية في التفكير.
شخصية لا تعطي لونًا واحدًا
كانت المعرفة والثقافة والتحصيل العلمي هي الشغل الشاغل لأحمد أمين، حتى إنه حزن حزنًا شديدًا على ما ضاع من وقته أثناء توليه المناصب المختلفة، ورأى أن هذه المناصب أكلت وقته وبعثرت زمانه ووزعت جهده مع قلة فائدتها، وأنه لو تفرغ لإكمال سلسلة كتاباته عن الحياة العقلية الإسلامية لكان ذلك أنفع وأجدى وأخلد.
امتازت كتاباته بدقة التعبير وعمق التحليل والنفاذ إلى الظواهر وتعليلها، والعرض الشائق مع ميله إلى سهولة في اللفظ وبعد عن التعقيد والغموض، فألّف حوالي 16 كتابًا كما شارك مع آخرين في تأليف وتحقيق عدد من الكتب الأخرى، وترجم كتابًا في مبادئ الفلسفة.
مناصبه
رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر من 1914م إلى 1954م.
عضو مراسل في «المجمع العلمي العربي» بدمشق منذ 1345 هـ / 1926م وفي «المجمع العلمي العراقي».
عضو بمجمع اللغة العربية سنة 1359 هـ /1940م.
عضو في المجلس الأعلى لدار الكتب سنة 1358 هـ / 1939م.
عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة 1939م.
مدير للإدارة الثقافية بوزارة المعارف 1945م.
مدير للإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية 1946م.
مؤلفاته
موسوعة فجر وضحى وظهر الإسلام.
يوم الإسلام.
قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية.
من زعماء الإصلاح.
زعماء الإصلاح في العصر الحديث.
كتاب الأخلاق.
حياتي.
فيض الخاطر (10 أجزاء).
الشرق والغرب.
النقد الأدبي (جزءان).
هارون الرشيد.
الصعلكة والفتوة في الإسلام.
المهدي والمهدوية.
إلى ولدي.
ابتسم للحياة.
حرب الشر.
علمتني الحياة .
كتب بالاشتراك
قصة الفلسفة اليونانية
قصة الفلسفة الحديثة (جزءان).
قصة الأدب في العالم (4 أجزاء).
كتب اشترك في نشرها
الإمتاع والمؤانسة.
ديوان الحماسة.
العقد الفريد.
الهوامل والشوامل.
كتب مترجمة
مبادئ الفلسفة.
كتب مدرسية
المنتخب من الأدب العربي.
المفصل في الأدب العربي.
المطالعة التوجيهية.
تاريخ الأدب العربي.
كتب قانونية
شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) ويقع في 818 صفحة نشرته لجنة التأليف والترجمة سنة 1934.
وفاته
أصيب أحمد أمين قبل وفاته بمرض في عينه، ثم بمرض في ساقه، فكان لا يخرج من منزله إلا لضرورة قصوى، ورغم ذلك لم ينقطع عن التأليف والبحث حتى توفاه الله في 27 رمضان 1373 هـ الموافق 30 مايو 1954م، فبكاه كثيرون ممن يعرفون قدره. ولعل كلمته: «أريد أن أعمل لا أن أسيطر» مفتاح مهم في فهم هذه الشخصية الكبيرة.
مؤلفات عنه
محمد رجب البيومي، أحمد أمين، مؤرخ الفكر الإسلامي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1422هـ/ 2001.
فهيم حافظ الدناصوري، أحمد أمين وأثره في اللغة والنقد الأدبي، مكتبة الملك فيصل الإسلامية، الهرم، مصر، 1986م.
لمعي المطيعي، هذا الرجل من مصر، دار الشروق، الطبعة الأولى، 1417هـ/ 1997م.
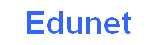





 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
